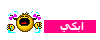فلو تزوج رجل امرأة وجعل من مهرها خزانة معينة موصوفة وذكر أن قيمتها خمسون ديناراً وسلمها الخزانة بالفعل، تعينت قيمة الخزانة بتسلمها لها عيناً. فلو أنه أخذها منها بعد ذلك وادّعت عليه بها فإن عليه تسليم عين الخزانة لا ثمنها فإن ثبت هلاك الخزانة أو ادعى هلاكها دفع لها خمسين ديناراً لأنها قيمة الخزانة سواء أكان مثل الخزانة عند الدعوى يساوي أكثر من خمسين ديناراً أو أقل، لأنها القيمة المقدرة فعلاً ولا يعتبر ثمن مثل الخزانة، بخلاف ما لو ذكر في العقد أن ثمنها خمسون ديناراً وسلمها الخزانة بالفعل ثم أخذها منها وادعت عليه بها فإن له تسليم الخزانة، وله دفع ثمنها خمسين ديناراً، وله أن يشتري لها خزانة بخمسين ديناراً سواء أكانت الخزانة عند الدعوى تساوي أكثر من خمسين أو أقل، فإن الواجب عليه دفع خزانة ثمنها خمسين ديناراً في كل وقت.
وذلك لأن القيمة لا تتغير والثمن يتغير. فالقيمة الفعلية للسلعة هي مقدار بدلها حين التقدير، وثمن السلعة هو ما يُدفع مقابلها مبادَلةً في السوق. وهذا التفريق بين القيمة والثمن إنّما هو في البيع وسائر أنواع المبادلة، أمّا إجارة الأجير فهي المقدار الذي تقدَّر فيه منفعة جهده عند العقد، وتقدَّر مرة أخرى عند انتهاء مدة الإجارة. ومن هنا يظهر أنه لا توجد علاقة بين أجرة الأجير وقيمة السلعة، ولا بين أجرة الأجير وتكاليف الإنتاج، ولا بين أجرة الأجير ومستوى المعيشة، وإنما هي شيء آخر منفصل، إذ هي مقدار ما تستحقه المنفعة التي يحصل منها عليه مستأجره، ويكون تقدير هذه المنفعة ليس راجعاً للمستأجِر بل راجعاً للحاجة لهذه المنفعة. فوحدة تقدير أجرة الأجير هي هذه المنفعة الموصوفة بهذا الوصف. وهذه الأجرة تختلف باختلاف الأعمال، وتتفاوت بتفاوت الإتقان في العمل الواحد، فأجرة المهندس تختلف عن أجرة النجار، وأجرة النجار الماهر تختلف عن أجرة النجار العادي، وإنما يرتفع أجر الناس في العمل الواحد بحسب ما يؤدّون من إتقان لمنفعة الجهـد، ولا يعتبر هذا ترقية لهم وإنما هو أجرهم الذي استحقوه بتحسينهم لمنفعتـه.
السبب الثاني من أسباب التملك
الإرث
ومن أسباب التملك للمال الإرث، وهو ثابت بنص القرآن القطعي، وله أحكام معينة توقيفية ولم تُعلَّل، وهو وإن كان قد نص على الجزئيات ولكن هذه الجزئيات خطوط عريضة، فالله تعالى حين يقول: )يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيَيْن فإن كُنّ نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك(، نفهم من قوله هذا عدة أحكام، نفهم منها أن الذكر من الأولاد يأخذ ضعف الأنثى، ونفهم منها أن ابن الابن يعامل معاملة الابن في حالة عدم وجود الأبناء، لأن أولاد الابن الذكر يندرجون تحت كلمة الأولاد، بخلاف ابن البنت فلا يعامَل معاملة ابن الابن في حالة عدم وجود الأبناء، لأن أولاد البنت لا يندرجون تحت كلمة أولاد في اللغة. ونفهم أيضاً أن الأولاد إن كانوا نساء فوق اثنتين فإنهن يشتركن في ثلثي التركة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للاثنتين حكم ما فوقهما، وأجمع الصحابة على ذلك فيكون للاثنتين حكم ما فوقهما. فهذه أحكام فُهمت من المعنى العام الذي ذكرته الآية. وبهذه الأحكام يستحق الوارث نصيبه من التركة. وعلى ذلك كان من أسباب التملك الإرث بحسب أحكامه المفصَّلة في الكتاب والسنّة وإجماع الصحابة.
والإرث وسيلة من وسائل تفتيت الثروة، وليس تفتيت الثروة علة له بل هي بيان لواقعه، وذلك أن الثروة وقد أبيحت ملكيتها، قد تتجمع في يد أفراد حال حياتهم، ولكي لا يستمر هذا التجمع بعد مماتهم كان لا بد من وسيلة لتفتيتها بين الناس. وقد شوهد في الواقع أن وسيلة تفتيت الثروة هذه طبيعياً هي الميراث. ومن الاستقراء تبين أن الأحوال التي تعتري تفتيت الثروة في الإرث ثلاث أحوال هي:
أ- الحالة الأولى أن يكون الورثة يستغرقون جميع المال حسب أحكام الإرث، وحينئذ يوزَّع عليهم المال كله.
ب- الحالة الثانية أن لا يكون هنالك ورثة يستغرقون جميع المال حسب أحكام الإرث، كما إذا توفي الميت عن زوجة فقط أو عن زوج فقط فإن الزوجة تأخذ الربع فقط ويكون باقي الميراث لبيت المال، وإن كان الزوج فإنه يأخذ النصف فقط ويكون باقي الميراث لبيت المال.
ج- أن لا يكون هنالك وارث مطلقاً، وفي هذه الحال يكون المال كله لبيت المال أي للدولة.
وبذلك تتفتت الثروة وينتقل المال إلى الورثة ويُستأنَف تبادل المال في دورة اقتصادية بين الناس ولا يُحفظ في شخص معين تتجمع لديه الثروات.
والإرث سبب مشروع للملكية، فمن ورث شيئاً مَلَكَه ملكاً مشروعاً. فيكون الإرث سبباً من أسباب التملك التي أذِنَ الشرع الإسلامي بها.
السبب الثالث من أسباب التملك
الحاجة للمال لأجل الحياة
من أسباب التملك الحاجة للمال لأجل الحياة. وذلك أن العيش حق لكل إنسان فيجب أن ينال هذا العيش حقاً لا مِنحةً ولا عطفاً. والسبب الذي يضمن للفرد من رعايا الدولة الإسلامية الحصول على قُوتِه هو العمل. فإذا تعذر عليه العمل كان على الدولة أن تهيئه له لأنها الراعي لهذه الرعية، والمسؤولة عن توفير حاجاتها، قال عليه الصلاة والسلام: {الإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعيته}، فإذا تعذر إيجاد عمل له أو عجز عن القيام بالعمل لمرض أو كِبَر سن أو أي سبب من أسباب العجز كان عيشه واجباً على من أوجب عليه الشرع الإنفاق عليه، فإن لم يوجَد من تجب عليه نفقته، أو وُجد وكان غير قادر على الإنفاق، كانت نفقته على بيت المال، أي على الدولة. وفوق ذلك كان له في بيت المال حق آخر وهو الزكاة، قال تعالى: )وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم(. وهذا الحق فرضٌ على الأغنياء أن يدفعوه، قال تعالى في آية: )إنّما الصدقات للفقراء والمساكين( من سورة التوبة )فريضة من الله( أي حقاً مفروضاً. وإن قصّرت الدولة في ذلك وقصّرت جماعة المسلمين في جماعتها وفي كفالة المحتاجين، وليس متوقعاً في جماعة المسلمين أن تقصّر، كان لهذا الفرد أن يأخذ ما يقيم به أَوَدَه من أي مكان يجده سواء أكان ملك الأفراد أو ملك الدولة. وفي هذه الحال لا يباح للجائع أن يأكل لحم الميتة ما دام هنالك أكلٌ عند أحد من الناس، لأنه لا يُعدّ مضطراً لأكل الميتة مع وجود ما يأكله في يد أي إنسان. أمّا إذا لم يستطع الحصول على الأكل فإن عليه أن يأكل لحم الميتة لإنقاذ حياته. ولمّا كان العيش سبباً من أسباب الحصول على المال لم يعتبِر الشارع أخذ الطعام المهيأ للأكل سرقة تُقطع اليد عليها، ولا اعتبر أخذ الطعام في عام المجاعة سرقة كذلك، فقد رُوي عن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا قطعٌ في الطعام المهيأ للأكل}، ورُوي عن مكحول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لا قطعٌ في مجاعة مُضطَر}. وكما ضمن الشرع حق الفرد في ملكية المال لأجل الحياة بالتشريع ضَمِنَ إعطاءه هذا الحق بالتوجيه، قال صلى الله عليه وسلم: {أيّما أهل عَرَصة أصبح فيهم امرؤ جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى}، وقال: {ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم}.
السبب الرابع من أسباب التملك
إعطاء الدولة من أموالها للرعية
ومن أسباب التملك إعطاء الدولة من أموال بيت المال للرعية، لسد حاجتهم أو للانتفاع بملكيتهم. أمّا سد حاجتهم فكإعطائهم أموالاً لزراعة أراضيهم أو لسد ديونهم. فقد أعطى عمر بن الخطاب من بيت المال للفلاحين في العراق أموالاً أعانهم بها على زراعة أرضهم وسدّ بها حاجتهم دون أن يستردها منهم. وقد جعل الشرع للمدينين حقاً في مال الزكاة يُعطَوْن منه لسد ديونهم إذا عجزوا عنها، قال تعالى: )والغارمين(، أي المدينين.
وأمّا حاجة الجماعة للانتفاع بملكية الفرد، فتكون في تمليك الدولة لأفراد الأمّة من أملاكها وأموالها المعطلة المنفعة، بأن تُقطِع الدولة بعض الأرض التي لا مالك لها، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقطع أبا بكر وعمر أرضاً، وكما أقطع الخلفاء الراشدون من بعده المسلمين أرضاً. فهذا الذي تُقطِعه الدولة للفرد يصبح ملكاً له بهذا الإقطاع لأن الجماعة في حاجة إلى هذه الملكية للانتفاع بها ولتسخير الفرد لهذا الانتفاع واستخدام نشاطه الذهني أو الجسمي للجماعة بسبب هذه الملكية. واستعمال لفظ الإقطاع هنا استعمال لغوي وفقهي ولا علاقة له بالنظام الإقطاعي الخاص الذي لم يعرفه الإسلام.
ويلحق بما تعطيه الدولة للأفراد ما توزعه على المحاربين من الغنائم، وما يأذن به الإمام بالاستيلاء عليه من الأسلاب.
السبب الخامس من أسباب التملك
الأموال التي يأخذها الأفراد دون مقابل مال أو جهد
ومن أسباب التملك أخذ الأفراد بعضهم من بعض مالاً دون مقابل مال أو جهد. وهذا يشمل خمسة أشياء:
1- صلة الأفراد بعضهم بعضاً، سواء أكانت الصلة في حياتهم كالهبة والهدية أو بعد وفاتهم كالوصية، فقد رُوي أن وفد هوازن لما جاؤوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يردّ عليهم ما غنمه منهم قال رسول الله: {ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم} أي فهو هبة مني إليكم، وقال عليه الصلاة والسلام: {تهادوا تحابّوا}، وقال صلى الله عليه وسلم: {ليس لنا مَثَلُ السوء الذي يعود في هِبَته كالكلب يعود في قيئه}. ولا فرق في الهبة والهدية بين الكافر والمسلم، فإعطاء الكافر مباح وقبول ما أعطى هو كقبول ما أعطى المسلم، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قَدِمَت أمّي عليّ وهي مشركة فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {صِلي أمك}، ورُوي عن أبي حميد الساعدي قال: {غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه برداً}. وكما أن الهبة والهدية هي التبرع بالمال حال الحياة فكذلك الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت، قال تعالى: )كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية(، ورُوي عن سعد بن مالك قال: مرضتُ مرضاً فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: {أوْصَيتَ؟} فقلت: نعم، أوصيت بمالي كله للفقراء وفي سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {أوصِ بالعشرة}. فقلت: يا رسول الله إن مالي كثير وورثتي أغنياء. فلم يزل رسول الله يناقصني وأناقصه حتى قال: {أوصِ بالثلث والثلث كثير}. ويملك الفرد بسبب الهدية أو الهبة أو الوصية العين الموهوبة أو المهداة أو الموصى بها.
2- استحقاق المال عِوَضاً عن ضرر من الأضرار التي لحقته، وذلك كدية القتيل وديات الجِراح، قال تعالى: )ومَن قَتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودِيَة مسلمة إلى أهله(، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: {في النفس المؤمنة مائة من الإبل}، وأمّا ديات الجِراح فقد رُوي عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له في كتاب {وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية}.
وفي دية المقتول يستحق ورثته ديته على القاتل في القتل العمد، قال عليه الصلاة والسلام: {لا يجنِ جانٍ إلاّ على نفسه}، وأمّا في غير العمد كشبه العمد والخطأ فيستحق ورثة المقتول الدية على العاقلة، فقد روى أبو هريرة قال: {اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها}، والعاقلة من يحمل العقل، والعقل هنا هو الدية، والعاقلة هي كل العَصَبة ويدخل فيها آباء القاتل وأبناؤه واخوته وعمومته وأبناؤهم. وإذا لم تكن للقاتل عاقلة أُخذت الدية من بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودى الأنصاري الذي قُتل بخيبر من بيت المال. ورُوي أن رجلاً قُتل في زحام في زمان عمر فلم يُعرف قاتله فقال عليّ لعمر: يا أمير المؤمنين لا يُطلُّ دم امرئ مسلم، فأدَّى ديته من بيت المال.
وأمّا ديات الجِراح وهي الشجاج في رأس أو وجه أو قطع عضو أو قطع لحم أو تفويت منفعة كتفويت السمع والبصر والعقل، فإذا حصل لإنسان جرح من هذه الجراح استحق الدية على هذا الجرح بحسب الأحكام المفصلة لكل عضو من الأعضاء ولكل حالة من الحالات. ويملك الفرد بسبب الدية المال الذي يخصه من دية المقتول أو دية العضو الذي تلف أو المنفعة التي فُوّتت.
3- استحقاق المهر وتوابعه بعقد النكاح، فإن المرأة تملك هذا المال على الوجه المفصل في أحكام الزواج، وليس هذا المال بدل منفعة، فإن المنفعة متبادلة بين الزوجين، وإنما هو مستحَق بنص الشرع، قال تعالى: )وآتوا النساء صَدُقاتهن نِحْلة( أي عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله تعالى، والنِحْلة العطيّة أيُّ عطيّة، لأن كل واحد من الزوجين يستمتع بصاحبه، و{روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رِدْعَ زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مَهيَم؟ فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتَ؟ قال: وزن نواة من ذهب، فقال: بارك الله لك، أوْلِم ولو بشاة}.
4- اللُّقَطة: إذا وجد شخص لُقَطة، يُنظر فإن كان يمكن حفظها وتعريفها كالذهب والفضة والجواهر والثياب وكان ذلك في غير الحَرَم جاز التقاطه للتملك، لِما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: {ما كان منها في طريق ميثاء (أي مسلوكة) فعرّفها حولاً فإن جاء صاحبها وإلاّ فهي لك}. أمّا إن كانت اللقطة في الحَرَم فلا تعتبر لقطة لأن لقطة الحَرَم حرام كما جاء في الحديث، ولا يجوز أن يأخذها إلاّ للحفظ على صاحبها.
أمّا إن كانت مما لا يمكن حفظها بأن كانت مالاً يبقى كالأكل والبطيخ وما شاكله فهو مخيَّر بين أن يأكله ويغرَم ثمنه لصاحبه إن وُجد، وبين أن يبيعه ويحفظ ثمنه مدة الحول. وهذا كله إذا كانت اللقطة مما يُطلب عادة بأن كان لها ثمن لا يتركه صاحبه إن ضاع. أمّا إن كانت من التوافه كالثمرة واللقمة وما شاكل ذلك فإنه لا يعرَّف عليه وإنما يملكه في الحال.