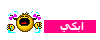أمور غفل عنها المسلمون
من كتاب الفتاوى الكبرى للإمام ابن تيمية
هل الإنسان إذا كان على غير طهر، وحمل المصحف بأكمامه، ليقرأ به، ويرفعه من مكان إلى مكان، هل يكره ذلك؟
فأجاب:
وأما إذا حمل الإنسان المصحف بكمه فلا بأس، ولكن لا يمسه بيديه.
هل من معه مصحف، وهو على غير طهارة، كيف يحمله؟
فأجاب:
ومن كان معه مصحف فله أن يحمله بين قماشه، وفي خرجه وحمله، سواء كان ذلك القماش لرجل، أو امرأة، أو صبى، وإن كان القماش فوقه أو تحته. والله أعلم.
وَسُئِلَ شيخُ الإِسلاَم عما تجب له الطهارتان: الغسل، والوضوء؟
فأجاب:
ذلك واجب للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع، فرضها ونفلها، واختلف في الطواف ومس المصحف. واختلف ـ أيضاً ـ في سجود التلاوة، وصلاة الجنازة، هل تدخل في مسمى الصلاة التي تجب لها الطهارة؟
وأما الاعتكاف فما علمت أحدا قال إنه يجب له الوضوء، وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض بذلك.
وأما القراءة ففيها خلاف شاذ:
فمذهب الأربعة تجب الطهارتان لهذا كله إلا الطواف مع الحدث الأصغر، فقد قيل: فيه نزاع. والأربعة ـ أيضًا ـ لا يجوزون للجنب قراءة القرآن، ولا اللبث في المسجد، إذا لم يكن على وضوء، وتنازعوا في قراءة الحائض، وفي قراءة الشيء اليسير. وفي هذا نزاع في مذهب /الإمام أحمد وغيره، كما قد ذكر في غير هذا الموضع.
ومذهب أهل الظاهر: يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، واللبث في المسجد، هذا مذهب داود وأصحابه، وابن حزم. وهذا منقول عن بعض السلف.
وأما مذهبهم فيما تجب له الطهارتان؟ فالذي ذكره ابن حزم أنها لا تجب إلا لصلاة: هى ركعتان، أو ركعة الوتر، أو ركعة في الخوف، أو صلاة الجنازة، ولا تجب عنده الطهارة لسجدتى السهو، فيجوز عنده للجنب والمحدث والحائض قراءة القرآن، والسجود فيه، ومس المصحف قال: لأن هذه الأفعال خير مندوب إليها، فمن ادعى منع هؤلاء منها فعليه الدليل.
وأما الطواف فلا يجوز للحائض بالنص، والإجماع.
وأما الحدث ففيه نزاع بين السلف، وقد ذكر عبد الله بن الإمام أحمد في المناسك بإسناده عن النخعى، وحماد بن أبي سليمان: أنه يجوز الطواف مع الحدث الأصغر، وقد قيل إن هذا قول الحنفية، أو بعضهم. وأما مع الجنابة والحيض فلا يجوز عند الأربعة، لكن مذهب أبي حنيفة أن ذلك واجب فيه لا فرض، وهو قول في مذهب أحمد./ وظاهر مذهبه كمذهب مالك والشافعي أنه ركن فيه. والصحيح في هذا الباب ما ثبت عن الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو أن مس المصحف لا يجوز للمحدث، ولا يجوز له صلاة جنازة، ويجوز له سجود التلاوة. فهذه الثلاثة ثابتة عن الصحابة.
وأما الطواف فلا أعرف الساعة فيه نقلا خاصًا عن الصحابة، لكن إذا جاز سجود التلاوة مع الحدث، فالطواف أولى، كما قاله من قاله من التابعين. قال البخاري في باب سجدة المسلمين مع المشركين: والمشرك نجس ليس له وضوء، وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء ووقع في بعض نسخ البخاري يسجد على وضوء. قال ابن بطال في شرح البخاري: الصواب إثبات غير؛ لأن المعروف عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء. ذكر ابن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا زكريا بن أبي زائدة، حدثنا أبو الحسن - يعنى عبيد ابن الحسن ـ عن رجل زعم أنه نسيه عن سعيد بن جبير قال: كان عبد الله بن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب، فيقرأ السجدة فيسجد، وما يتوضأ. وذكر عن وكيع عن زكريا عن الشعبي في الرجل يقرأ السجدة على غير وضوء، قال: يسجد حيث كان وجهه.
قال ابن المنذر: واختلفوا في الحائض تسمع السجدة فقال عطاء وأبو قِلابة، والزهري، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وإبراهيم/وقتادة: ليس عليها أن تسجد، وبه قال مالك والثوري والشافعي، وأصحاب الرأي. وقد روينا عن عثمان بن عفان قال تومئ برأسها. وبه قال سعيد بن المسيب قال تومئ، وتقول: لك سجدت.
وقال ابن المنذر في ذكر من سمع السجدة وهو على غير وضوء: قال أبو بكر، واختلفوا في ذلك. فقالت طائفة يتوضأ ويسجد، هكذا قال النخعي وسفيان الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. وقد روينا عن النخعي قولا ثالثًا أنه يتيمم ويسجد، وروينا عن الشعبي قولا ثالثًا أنه يسجد حيث كان وجهه. وقال ابن حزم ـ وقد روي عن عثمان بن عفان، وسعيد بن المسيب ـ تومئ الحائض بالسجود، وقال سعيد: وتقول: رب لك سجدت. وعن الشعبي جواز سجود التلاوة إلى غير القبلة.
وأما صلاة الجنازة، فقد قال البخاري: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من صلى على الجنازة). وقال: (صلوا على صاحبكم)، وقال: (صلوا على النجاشي) سماها صلاة وليس فيها ركوع ولا سجود، ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير، وتسليم. قال: وكان ابن عمر لا يصلى إلا طاهرًا، ولا يصلى عند طلوع الشمس، ولا غروبها، ويرفع يديه.
/قال ابن بطال: عرض البخاري للرد على الشعبي، فإنه أجاز الصلاة على الجنازة بغير طهارة، قال: لأنها دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود. والفقهاء مجمعون من السلف والخلف على خلاف قوله، فلا يلتفت إلى شذوذه، وأجمعوا أنها لا تصلى إلا إلى القبلة، ولو كانت دعاء كما زعم الشعبي لجازت إلى غير القبلة. قال: واحتجاج البخاري في هذا الباب حسن.
قلت: فالنزاع في سجود التلاوة، وفي صلاة الجنازة. قيل: هما جميعًا ليسا صلاة، كما قال الشعبي ومن وافقه، وقيل: هما جميعاً صلاة تجب لهما الطهارة. والمأثور عن الصحابة وهو الذي تدل عليه النصوص والقياس: الفرق بين الجنازة، والسجود المجرد سجود التلاوة والشكر. وذلك لأنه قد ثبت بالنص لا صلاة إلا بطهور، كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ). وفي صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول).
وهذا قد دل عليه القرآن بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} الآية [المائدة: 6]، وقد حرم الصلاة مع الجنابة والسكر في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ} [النساء: 43].
وثبت ـ أيضًا ـ أن الطهارة لا تجب لغير الصلاة، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن جريج: ثنا سعيد بن الحارث، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء، فقرب له طعام فأكل، ولم يمس ماء). قال ابن جريج وزادنى عمرو بن دينار عن سعيد بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إنك لم تتوضأ. قال: (ما أردت صلاة فأتوضأ) قال عمرو: سمعته من سعيد بن الحارث.
والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلا، فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح، ولا ضعيف، أنه أمر بالوضوء للطواف، مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة، وقد اعتمر عُمَرَا متعددة، والناس يعتمرون معه، فلو كان الوضوء فرضًا للطواف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانًا عامًا، ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه، ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ. وهذا وحده لا يدل على الوجوب، فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة، وقد قال:(إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر) فيتيمم لرد السلام.
/وقد ثبت عنه في الصحيح أنه لما خرج من الخلاء وأكل وهو محدث قيل له: ألا تتوضأ؟ قال: (ما أردت صلاة فأتوضأ). يدل على أنه لم يجب عليه الوضوء إلا إذا أراد صلاة، وأن وضوءه لما سوى ذلك مستحب ليس بواجب. وقوله صلى الله عليه وسلم: (ما أردت صلاة فأتوضأ) ليس إنكارًا للوضوء لغير الصلاة، لكن إنكار لإيجاب الوضوء لغير الصلاة؛ فإن بعض الحاضرين قال له: ألا تتوضأ؟ فكأن هذا القائل ظن وجوب الوضوء للأكل، فقال صلى الله عليه وسلم: (ما أردت صلاة فأتوضأ) فبين له أنه إنما فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة.
والحديث الذي يروى: (الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير)، قد رواه النسائي، وهو يروى موقوفًا ومرفوعًا، وأهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا موقوفًا ويجعلونه من كلام ابن عباس لا يثبتون رفعه، وبكل حال فلا حجة فيه؛ لأنه ليس المراد به أن الطواف نوع من الصلاة كصلاة العيد، والجنائز؛ ولا أنه مثل الصلاة مطلقًا، فإن الطواف يباح فيه الكلام بالنص والإجماع، ولا تسليم فيه، ولا يبطله الضحك والقهقهة، ولا تجب فيه القراءة باتفاق المسلمين، فليس هو مثل الجنازة، فإن الجنازة فيها تكبير وتسليم، فتفتح بالتكبير، وتختم بالتسليم.
وهذا حد الصلاة التي أمر فيها بالوضوء، كما قال صلى الله عليه وسلم: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)، والطواف ليس له تحريم، ولا تحليل، وإن كبر في أوله، فكما يكبر على الصفا والمروة، وعند رمى الجمار، من غير أن يكون ذلك تحريمًا، ولهذا يكبر كلما حاذى الركن، والصلاة لها تحريم؛ لأنه بتكبيرها يحرم على المصلي ما كان حلالا له من الكلام، أو الأكل، أو الضحك، أو الشرب، أو غير ذلك، والطواف لا يحرم شيئًا، بل كل ما كان مباحًا قبل الطواف في المسجد، فهو مباح في الطواف، وإن كان قد يكره ذلك لأنه يشغل عن مقصود الطواف، كما يكره في عرفة، وعند رمي الجمار، ولا يعرف نزاعًا بين العلماء أن الطواف لا يبطل بالكلام والأكل والشرب والقهقهة، كما لا يبطل غيره من مناسك الحج بذلك. وكما لا يبطل الاعتكاف بذلك.
والاعتكاف يستحب له طهارة الحدث، ولا يجب، فلو قعد المعتكف وهو محدث في المسجد لم يحرم، بخلاف ما إذا كان جنبًا أو حائضًا، فإن هذا يمنعه منه الجمهور، كمنعهم الجنب والحائض من اللبث في المسجد لا لأن ذلك يبطل الاعتكاف؛ ولهذا إذا خرج المعتكف للاغتسال كان حكم اعتكاف عليه في حال خروجه، فيحرم عليه مباشرة النساء في غير المسجد. ومن جوز له اللبث مع الوضوء، جوز للمعتكف أن يتوضأ /ويلبث في المسجد، وهو قول أحمد بن حنبل وغيره.
والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الحائض عن الطواف، وبعث أبا بكر أميرًا على الموسم، فأمر أن ينادى: (ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان). وكان المشركون يحجون وكانوا يطوفون بالبيت عراة، فيقولون: ثياب عصينا الله فيها فلا نطوف فيها، إلا الحمس، ومن دان دينها. وفي ذلك أنزل الله:{يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 13]، وقوله: {وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً} مثل طوافهم بالبيت عراة {قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 28].
ومعلوم أن ستر العورة يجب مطلقا، خصوصًا إذا كان في المسجد الحرام والناس يرونه، فلم يجب ذلك لخصوص الطواف، لكن الاستتار في حال الطواف أوكد لكثرة من يراه وقت الطواف، فينبغى النظر في معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، وهو أن يعرف مسمى الصلاة التي لا يقبلها الله إلا بطهور، التي أمر بالوضوء عند القيام إليها. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الذي في السنن عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم). ففي هذا الحديث دلالتان:
/إحداهما: أن الصلاة تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، فما لم يكن تحريمه التكبير، وتحليله التسليم لم يكن من الصلاة.
والثانية: أن هذه هي الصلاة التي مفتاحها الطهور، فكل صلاة مفتاحها الطهور، فتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، فما لم يكن تحريمه التكبير، وتحليله التسليم، فليس مفتاحه الطهور، فدخلت صلاة الجنازة في هذا، فإن مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
وأما سجود التلاوة والشكر، فلم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه أن فيه تسليما، ولا أنهم كانوا يسلمون منه؛ ولهذا كان أحمد بن حنبل وغيره من العلماء لا يعرفون فيه التسليم. وأحمد في إحدى الروايتين عنه لا يسلم فيه؛ لعدم ورود الأثر بذلك. وفي الرواية الأخرى يسلم واحدة أو اثنتين، ولم يثبت ذلك بنص، بل بالقياس، وكذلك من رأي فيه تسليما من الفقهاء ليس معه نص، بل القياس، أو قول بعض التابعين.
وقد تكلم الخطابي على حديث نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد، وسجدنا معه. قال: فيه بيان أن السنة أن يكبر /للسجود، وعلى هذا مذاهب أكثر أهل العلم، وكذلك يكبر إذا رفع رأسه من السجود، قال: وكان الشافعي وأحمد يقولان يرفع يديه إذا أراد أن يسجد. وعن ابن سيرين وعطاء: إذا رفع رأسه من السجود يسلم. وبه قال إسحاق بن راهويه.
قال: واحتج لهم في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وكان أحمد لا يعرف ـ وفي لفظ ـ لا يرى التسليم في هذا.
قلت: وهذه الحجة إنما تستقيم لهم أن ذلك داخل في مسمى الصلاة، لكن قد يحتجون بهذا على من يسلم أنها صلاة، فيتناقض قوله. وحديث ابن عمر رواه البخاري في صحيحه وليس فيه التكبير. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد، حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. وفي لفظ: حتى ما يجد أحدنا مكانا لجبهته.
فابن عمر قد أخبر أنهم كانوا يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر تسليما، وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء، ومن المعلوم أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه أن السجود لا يكون إلى على وضوء، لكان هذا مما يعلمه عامتهم؛ لأنهم كلهم/كانوا يسجدون معه، وكان هذا شائعا في الصحابة، فإذا لم يعرف عن أحد منهم أنه أوجب الطهارة لسجود التلاوة، وكان ابن عمر من أعلمهم وأفقههم وأتبعهم للسنة، وقد بقى إلى آخر الأمر ويسجد للتلاوة على غير طهارة، كان هو مما يبين أنه لم يكن معروفا بينهم أن الطهارة واجبة لها. ولو كان هذا مما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك شائعًا بينهم، كشياع وجوب الطهارة للصلاة، وصلاة الجنازة، وابن عمر لم يعرف أن غيره من الصحابة أوجب الطهارة فيها، ولكن سجودها على الطهارة أفضل باتفاق المسلمين.
وقد يقال: إنه يكره سجودها على غير طهارة مع القدرة على الطهارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه مسلم لم يرد عليه حتى تيمم، وقال: كرهت أن أذكر الله إلاَّ على طهر، فالسجود أوكد من رد السلام. لكن كون الإنسان إذا قرأ وهو محدث يحرم عليه السجود، ولا يحل له أن يسجد للَّه إلا بطهارة، قول لا دليل عليه. وما ذكر أيضاً يدل: على أن الطواف ليس من الصلاة، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب) /والطواف والسجود لا يقرأ فيهما بأم الكتاب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة) والكلام يجوز في الطواف، والطواف ـ أيضًا ـ ليس فيه تسليم، لكن يفتتح بالتكبير، كما يسجد للتلاوة بالتكبير، ومجرد الافتتاح بالتكبير لا يوجب أن يكون المفتتح صلاة. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء بيده، وكبر. وكذلك ثبت عنه: أنه كبر على الصفا والمروة، وعند رمى الجمار؛ ولأن الطواف يشبه الصلاة من بعض الوجوه.
وأما الحائض: فقد قيل: إنما منعت من الطواف لأجل المسجد، كما تمنع من الاعتكاف لأجل المسجد، والمسجد الحرام أفضل المساجد، وقد قال تعالى لإبراهيم: {أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة: 125]، فأمر بتطهيره، فتمنع منه الحائض من الطواف، وغير الطواف وهذا من سر قول من يجعل الطهارة واجبة فيه، ويقول: إذا طافت وهى حائض عصت بدخول المسجد مع الحيض، ولا يجعل طهارتها للطواف كطهارتها للصلاة، بل يجعله من جنس منعها أن تعتكف في المسجد وهى حائض؛ ولهذا لم تمنع الحائض من سائر المناسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الحائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت)، وقال لعائشة: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت). ولما قيل له عن صفية: إنها حائض قال: (أحابستنا هي؟) قيل له: إنها قد أفاضت، قال:(فلا إذًا) متفق عليه.
وقد اعترض ابن بطَّال على احتجاج البخاري بجواز السجود على غير وضوء بحديث ابن عباس: (إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ [النجم] فسجد، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس) وهذا السجود متواتر عند أهل العلم، وفي الصحيح ـ أيضًا ـ من حديث ابن مسعود قال: (قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بمكة النجم فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفًا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته، وقال: يكفينى هذا، قال: فرأيته بعدُ قُتِل كافرًا).
قال ابن بطَّال: هذا لا حجة فيه؛ لأن سجود المشركين لم يكن على وجه العبادة للَّه، والتعظيم له، وإنما كان لما ألقى الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر آلهتهم في قوله: {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى} [النجم: 19، 20]، فقال: تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن قد ترتجى، فسجدوا لما سمعوا من تعظيم آلهتهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ما ألقى الشيطان على لسانه من ذلك أشفق وحزن له، فأنزل الله ـ تعالى ـ تأنيساً له وتسلية عما عرض له: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ} إلى قوله: {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [الحج: 52]، أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته.
فلا يستنبط من سجود المشركين جواز السجود على غير/وضوء؛ لأن المشرك نجس لا يصح له وضوء، ولا سجود إلا بعد عقد الإسلام.
فيقال: هذا ضعيف، فإن القوم إنما سجدوا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: {أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا}
[النجم:59-62]، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه امتثالا لهذا الأمر، وهو السجود للَّه والمشركون تابعوه في السجود الله.