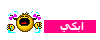ويؤكد علي عزت ان افكار «البير كامي» لا يمكن فهمها إلاّ إذا اعتبرنا صاحبها مؤمناً مخيب الرجاء، ويستشهد على ذلك بفقرة من «كامي» يقول فيها: «في عالم خبا فيه الوهم فجأة وانطفأ الضياء يشعر الإنسان بالاغتراب.. فلا ذكريات هنالك ولا وطن مفقود.. ولا أمل في الوصول إلى ارض موعودة.. كل شيء جائز طالما ان الإنسان يموت وان الله غير موجود». يقول علي عزّت «ان هذه العبارة الاخيرة ليس بينها شيء مشترك وبين الالحاد القاطع اليقيني الذي نصادفه عند المفكرين العقلانيين، انما على العكس هو صرخة صامتة لروح أجهدها البحث عن الله ولم تجده.. انها الحاد البائس».
هذا موقف انساني يتكرر على مر العصور والدهور كلما امعن الإنسان النظر في سر حياته ومصيره دون ان يتصل بمصدر هداية يدله على طريق الخلاص، وفي هذا تكمن الحكمة في الآية القرآنية التي ساقها علي عزت لتلقي ضوءاً على هذا المأزق وتوجه النظر إلى طريق الخروج منه: «أفحسبتم انما خلقناكم عبثاً وانكم الينا لا ترجعون».
يتألف كتاب «الإسلام بين الشرق والغرب» من أحد عشر فصلاً منقسمة إلى قسمين، يشتمل القسم الاول على ستة فصول ويحمل عنواناً عاماً هو (نظرات حول الدين)، ولكنه يتناول موضوعات وقضايا اساسية في الفكر الإنساني كالخلق والتطور، والثقافة والحضارة، والظاهرة الفنية، والاخلاق، والتاريخ، والدراما والطوبيا. ويدهش القارىء: لم اذن اختار المؤلف لهذه الفصول عنواناً جامعاً كهذا..؟
هل يمكن قيام اخلاق بلا إله؟
هنا تكمن عبقرية المؤلف وتتجلى قدرته التحليلية ومنطقه القوي، حيث ينكشف لنا بعد التحليل وجود عناصر دينية اصيلة في نسيج الثقافة والفن والاخلاق، بل يرى علي عزت ان هذه الموضوعات تدور في حقيقتها على محور ديني ولا يمكن ان تنفصم عنه. ويرينا كيف ان محاولات بعض الفلاسفة اقامة اخلاق على مبادىء اخرى غير دينية كالمنفعة وغيرها قد باءت بالفشل، ولذا يتساءل قائلاً: هل يمكن وجود اخلاق بلا إله؟ خصوصاً واننا نصادف في حياتنا اليومية ملحدين على اخلاق ورجال دين لا اخلاق لهم!! ويمضي المؤلف يطوف بنا في اعماق الفكر الإنساني وفي تجارب الامم ماضيها وحاضرها، لنرى ان اشد الانظمة الحاداً ومادية لم تتمكن من بناء مجتمع ملحد كامل الالحاد. وضرب على ذلك مثلاً بالنظم الماركسية التي تقطع مبادؤها عند ماركس ولينين بـأن الاخلاق والإنسانيّة والدين كلها اوهام يجب القضاء عليها، ومع ذلك لم يفلح الماركسيون في الالتزام بهذه المبادىء عند التطبيق العملي لانها تصطدم بجوهر الحياة الإنسانيّة وفي ذلك يقول علي عزت: «لقد كان ماركس يستطيع وهو قابع في مقعده بالمكتبة البريطانية ان يقول بأنه لا وجود للاخلاق ولكن الذين حاولوا تطبيق افكار ماركس وان يقيموا مجتمعاً على اساسها لم يستطيعوا ان يعلنوا هذا الكلام بنفس السهولة. فلكي يقيموا مجتمعاً ويحافظوا على بقائه كان عليهم ان يطلبوا من الناس درجة من المثالية ربما اكثر مما طلب اي نبي من قومه باسم الدين. ولهذا كان عليهم ان يتناسوا بعض المسلمات المادية الواضحة». وهكذا يؤكد علي عزت ان الالحاد إذا وضع موضع الممارسة وهو يحاول بناء مجتمع يضطر صاغراً إلى المحافظة على الاشكال القائمة للاخلاق الاجتماعية، ولكنه في نفس الوقت لا يملك الوسيلة لحماية المبدأ الاخلاقي أو الدفاع عنه إذا وضع موضع التساؤل أو الشك. هنالك يبدو الالحاد عاجزاً تماماً أمام هجوم دعاة المنفعة أو الانانية أو اللاأخلاقية، فعندما يقولون: «إذا كنت سأحيا اليوم فقط وسأموت غدا لا محالة وبلا عودة إلى حياة اخرى فلم لا أعيش اليوم كما يحلو لي بدون قيد أو التزام ما استطعت إلى ذلك سبيلاً؟ هنا لانجد اجابة منطقية عند اصحاب المذاهب المادية والالحادية.. وسنجد ان الذي يترسب في وعي الناس هو المعايير الاخلاقية الموروثة فحسب.. وتضطر الدولة الملحدة ان تبقى عليها بدافع الضرورة المحضة».
وهكذا ننتهي إلى نتيجتين: الاولى ان الاخلاق كمبدأ لا توجد بلا دين بينما الاخلاق العملية يمكن ان توجد في غياب الدين ولكن يظل وجودها ضعيفاً واهنا لانفصالها عن المصدر الذي منحها قوتها المبدئية، والنتيجة الثانية انّه لا يمكن بناء نظام اخلاقي على الالحاد.. وفي كلتا الحالتين يظل النظام الاخلاقي الموروث مناقضاً للايديولوجية الرسمية ولا يوجد له مكان فيها.
التمييز بين الثقافة والحضارة
يبدو من دراسة علي عزت لموضوع الثقافة والحاضرة ان هناك تصادماً بينهما، وان الحضارة الرأسمالية والحضارة الشيوعية كلاهما معاد للثقافة بطبيعتهما وبدرجات مختلفة ذلك ان الثقافة في جذورها الاولى صدرت من أصل ديني، وان هذه الجذور تمتد من الماضي السحيق إلى ما يسميه علي عزت «بالتمهيد السماوي»، ويشير إلى ذلك السناريو القرآني الذي جمع الله فيه الارواح التي قُدر لها ان تولد ـ (كما يقول الفلاسفة المسلمون «في عالم الذرّ») ـ وسألهم: «ألست بربكم.. قالوا بلى..» هنالك علم الإنسان انّه مختلف عن بقية الكائنات وانّه صاحب مسؤولية وانّه حر الاختيار.
ويطوّر المؤلف موضوع الصدام بين الثقافة والحضارة بطرق مختلفة. فالثقافة عنده «هي تأثير الدين على الإنسان وتأثير الإنسان على الإنسان، بينما الحضارة هي تاثير العقل على الطبيعة.. تعني الثقافة الفن الذي يكون به الإنسان انسانا اما الحضارة فهي فن يتعلق بالوظيفة والسيطرة وصناعة الاشياء تامة الكمال.. الحضارة هي استمرارية التقدم التقني وليس التقدم الروحي.. كما ان التطور الداروني هو استمرارية للتقدم البيولوجي وليس التقدم الإنساني.
الثقافة شعور دائم الحضور بالاختيار وتعبير عن الحرية الإنسانيّة وخلافا لما تذهب إليه الحكمة الإسلامية بضرورة كبح الشهوات، يحكم الحضارة منطق آخر جعلها ترفع شعاراً مضاداً «اخلق شهوات جديدة دائماً وابداً». الحضارة تُعلم اما الثقافة فتنوّر، تحتاج الاولى إلى تعليم والثانية إلى التأمّل.
تملك الثقافة الفن وتملك الحضارة العلم. تقف الثقافة بمعنى من المعاني خارج اطار الزمن والتاريخ، فهي معنية بموضوع واحد هو: لِمَ نحيا؟ اما الحضارة فهي اجابة على سؤال آخر دائم التغير وهو: كيف نحيا؟. وفي هذا المجال «يمكن تمثيل الحضارة بخط صاعد دائماً يبدأ من اكتشاف الإنسان للنار مارا خلال طواحين الماء ثم عصر الحديد والكتابة، والآلة البخارية، حتى عصر الطاقة الذرية ورحلات الفضاء. اما الثقافة فهي بحث دائب يعود إلى الوراء ويبدأ من جديد. الإنسان هو موضوع الثقافة بأخطائه التي لا تتغير وفضائله وشكوكه وضلالاته.. وكلما تعمقنا في الوجود الداخلي للانسان نرى معضلة دائمة تسعى إلى حل مستحيل».
هذه هي مجمل المجالات التي ناقش فيها علي عزت موضوع الاختلاف بين الثقافة والحضارة حيث ينتهي من مناقشاته وتحليلاته إلى ان الحضارة الحديثة قد اخفقت اخفاقاً بيّناً في سعيها لتحقيق السعادة الإنسانيّة المنشودة من خلال العلم والقوة والثروة. ويؤكد انّه لابد من فهم هذه الحقيقة والاعتراف بها حتى يتسنى لنا مراجعة افكارنا الاساسية التي لا تزال موضع قبول عام إلى الآن.. ويرى ان «أول فكرة يجب مراجعتها هي فكرة العلم الخاطئة عن الإنسان».
ولكن يحذرنا علي عزت ان نفهم ان نقده للحضارة دعوة لرفضها والانعزال عنها فالحضارة على حد قوله «لا يمكن رفضها حتى لو رغبنا في ذلك.. انما الشيء الوحيد والضروري والممكن فهو ان نحطم الاسطورة التي تحيط بها.. فان تحطيم الاسطورة سيؤدي إلى مزيد من أنْسنة هذا العالم.. وهي مهمة تنتمي بطبيعتها إلى الثقافة».
إخفاق الايديولوجيات الكبرى
ويُرجع المؤلف اخفاق الايديولوجيات الكبرى في العالم إلى نظرتها إلى الإنسان والحياة نظرة احادية الجانب شطرت العالم شطرين متصادمين بين مادية ملحدة وكاثوليكية مغرقة في الاسرار «ينكر كل منهما الآخر ويدينه بلا أمل في لقاء»، وهكذا وجدنا الحضارة القائمة على العلم المادي من جانب، والدين القائم على الغيبيات من جانب آخر مضاد. ولكن الإسلام ـ كما يعرضه علي عزت ـ لا يخضع لهذه القسمة الجائرة. وتلك هي القضية الكبرى التي يعالجها علي عزت في كتابه «الإسلام بين الشرق والغرب» حيث خصص لها القسم الثاني من هذا الكتاب.
الإسلام وحدة ثنائية القطب
يرى علي عزت انّه يستحيل تطبيق الإسلام تطبيقاً صحيحاً في مجتمع متخلف ففي اللحظة التي يتم فيها التطبيق الحقيقي للاسلام في مجتمع ما يكون هذا المجتمع قد بدأ يتخلى عن تخلفه ويدخل في مجال الحضارة.
ومن ثم يؤكد القرآن ان الله خلق الإنسان ليكون سيداً في الارض وخليفة الله عليها.. وان الإنسان في امكانه تسخير الطبيعة والعالم من خلال العلم والعمل. ويقول علي عزت في موضع آخر: «ان اصرار القرآن على حق محاربة الشر والظلم ليس من قبيل التدين بمعناه الضيق، فمبادىء اللاعنف واللامقاومة اقرب إلى الدين المجرد.. وعندما اقر القرآن القتال بل أمر به بدلاً من الرضوخ للظلم والمعاناة لم يكن يقرر مبادىء دين مجرد أو اخلاق وانما كان يضع قواعد سياسية واجتماعية». ويعلق على تحريم الخمر في الإسلام بقوله: «كان تحريم الخمر بالدرجة الاولى معالجة لشر اجتماعي وليس في الدين المجرد شيء ضد الخمر بل ان بعض الاديان استخدمت الكحول كعامل صناعي لاستحضار النشوة الروحية.. كالاظلام والبخور المعطّرة، وكلها وسائل تؤدي إلى هذا النوع من الخدر المطلب للتأمل الخالص.. ولكن الإسلام عندما حرّم الخمر سلك مسلك العلم لا مسلك الدين المجرد».
سرّ انحطاط المسلمين
ويتساءل علي عزت: ما الذي أدّى اذن بالمسلمين إلى الانحطاط بالصورة التي نراها اليوم؟ ويجيب على تساؤله بقوله: «لقد انشطرت وحدة الإسلام ثنائية القطب على يد اناس قصروا الإسلام على جانبه الديني المجرد فأهدروا وحدته وهي خاصيته التي ينفرد بها دون سائر الاديان.. لقد اختزلوا الإسلام إلى دين مجرد أو إلى صوفية فتدهورت احوال المسلمين. وذلك لان المسلمين عندما يضعف نشاطهم وعندما يهملون دورهم في هذا العلم ويتوقفون عن التفاعل معه تصبح السلطة في الدولة المسلمة عارية لا تخدم إلاّ نفسها.. ويبدأ الدين الخامل يجر المجتمع نحو السلبية والتخلف، ويشكّل الملوك والامراء والعلماء الملحدون ورجال الكهنوت وفرق الدراويش والصوفية المغيبة، والشعراء السكارى ـ يشكلون جميعاً الوجه الخارجي للانشطار الداخلي الذي أصاب الإسلام».
العداء الغربي للاسلام
وفي هذا المجال يلفت علي عزت النظر إلى ان عداء الغرب الحالي للاسلام ليس مجرد امتداد للعداء التقليدي والصدام الحضاري الذي وصل إلى الصراع العسكري بين الإسلام والغرب منذ الحملات الصليبية حتى حروب الاستقلال وانما يرجع هذا العداء بصفة خاصة إلى تجربة الغرب التاريخية مع الدين والى عجزه عن فهم طبيعة الإسلام المتميزة. وهو يطرح لذلك سببين جوهريين وراء هذا العجز وهما: طبيعة العقل الاوروبي احادي النظرة، والى قصور اللغات الاوروبية عن استيعاب المصطلحات الإسلامية وضرب لذلك مثلا بمصطلحات: الصلاة والزكاة والصيام والوضوء والخلافة والاُمّة، حيث لا يوجد ما يقابلها في المعنى باللغات الاوروبية. فالمصطلحات الإسلامية ـ كما يراها علي عزت ـ كالاسلام نفسه تنطوي على وحدة ثنائية القطب. ولهذين السببين ـ كما يقرر علي عزت ـ «انكر الماديون الغربيون الإسلام باعتباره دين غيبيات أي (اتجاه يميني) بينما انكره المسيحيون الغربيون لانهم يرون فيه حركة اجتماعية سياسية اي «اتجاه يساري».. وهكذا انكر الغربيون الإسلام لسببين متناقضين».
ويرى المؤلف بحق ان الغرب إذا كان يريد فهم الإسلام فهما صحيحاً عليه ان يعيد النظر في مصطلحاته التي تتعلق بالاسلام.
بهذا المنطق القوي والمنهج التحليلي المقتدر يكشف علي عزت عن تهافت الفكر الغربي وقصوره بل تناقضه في معالجته لموضوع الإنسان والحياة، ويرتفع بالفكر الاسلامي إلى مستواه العالمي الذي يليق به، ولا اجد في هذا المجال اصدق من شهادة «وودز ورث كارلسن» وهو مفكر اوروبي محايد لا ينتمي إلى دين المؤلف ولا إلى عشيرته حيث يقال معلقاً على كتاب الإسلام بين الشرق والغرب: «ان تحليله للاوضاع الإنسانيّة مذهل وقدرته التحليلية الكاسحة تعطي شعوراً متعاظماً بجمال الإسلام وعالميته».