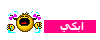عبراتٌ من خُزامى
تحلق هي بخيالها في سماء فؤاده ، تجذبه بدفء المشاعر التي تبثها ناعمة كرذاذ غيثٍ عابر ، يداعب وجنتيه بلطف أزلي ، ويبعث السرور إلى ملامح طالما أرهقتها عُسرة الأحداث ، ترسم بنور طلعتها في عينيه صورةً لا أحب إلى قلبه منها ، تتمثل في ناظريه كبجعة بيضاء نقية ترفرف بأجنحتها معانقة فضاء الكون وهي تقاوم خيوط الجاذبية الخفية ، منطلقةً إلى الأفق البعيد ، منطلقة إلى حيث النور يتلألأ ؛ إلى حيثُ الشعاع الناعم يذوب في صُفيحات الماء الرقيقة ، إلى حيث الأمل يغني ، ويُنشد أمنيات الشباب في ربيع الأزهار.
عيناها ، عيناها كما أخفيتا من أسرار ، عيناها الدافئتان ، وما عيناها ، كم تدفقت منهما مياه الحياة ، وكم هما غزيرتان ، كنبعٍ صافٍ لا قعر له ، إكسيرٌ للحياة هما ، بهجةٌ للروح ، ونبعٌ للعطاء ، كم من حوار قد شاركتاه فيه ، عندما عجز اللسان ، وحار البيان ، عندما هيمن الصمت على المكان ، انطلقتا تحكيان عن حكايات الزمان ، عن أساطير الأرض ، عن أحاديث الإنسان ، عن مخلوق كان وكان ، عن السرور ، عن الرضا ، عن القناعة التي حققت لأصحابها منىً لا تُران ، لترتسم بهجةٌ على محياه ، وينبعث شعاعُ دفءٍ إلى قلبه الوحيد ، ولتطفق عيناه تتبادلان حديث الروح مع تلك اللؤلؤتين المكنونتين في نبع الروح العميق ذاك.
صوتها العذب ينساب إلى مسامعه كلحن صافٍ ، كأرجوزةٍ هادئةٍ تلامس وتر أشجانهِ ، فتزيل ما كدرها من همومٍ ، وتخفف ما اعتراها من آلام ، كترانيم ألحانٍ حزينة ، ينطلق ذلك الطيف اللامرئي ، حاملاً في طياته من كل نواحي الحياة ألواناً ، من كل بساتين المحبة ينتخب زهرة فضفاضة ؛ من الصدق ، من الود ، من الحنان ، ساعةَ ينطق ذلك النسيم العليل ، والذي قليلاً ما يتحدث ، ساعتها يود لو أن الحال تطول به وتبقيه مكانه ، مشدوهاً إلى عالمها ، والذي كم يود أن يلجه ويكشف عن أسراره ، منجذباً إلى سحرها ، غارقاً في عبق وحيها ، كم تمنى أن يبقى هنالك ، وأنَ الدنيا والوقت يتوقفان ، ويتركاهما في حاليهما ، ولكن ، شأن الأمور كلها ، لا تشعر بالوقت عندما تكون مصطبغاً بألوان الفرح ونشوة الأحلام.
بقدر ما أنه لا يستطيع إزاحة صورتها عن مخيلته ، ولو للحظة واحدة ، يجد الصعوبة ذاتها في تذكر التفاصيل الدقيقة ، والأحداث التي قادته ، تدلها أيادي القدر ، إلى لُقياها ، كل ما يتذكره ، كل ما تسعفه ذاكرته به ، هو أن اليوم الذي دفعه إلى ذلك المكان الذي لم تطأه رجلاه من قبل ، كان يوماً مشمساً من أيام فصل الربيع ، كانت الشمس فيه مستوليةً على مرج السماء وحدها ، فسحب الشتاء كانت قد تقهقرت ، والأمطار كانت قد توقفت ، والخُضرة قد لفحت المكان ، كان نسيم الهواء منعشاً ، يعطي الجسد نشاطاً غريبا ، لكن ما أسر تفكيره من هموم منعه من أن يستمتع ببهجة اليوم وإشراقته ، كان للتو عائداً من الجامعة ، يجر أذيال الخيبة وراءه ، وينعل خُفين قيل أن حُنيناً كان يملكهما يوماً ، لم يكن اسمه موجوداً ، لم تكن قائمة المقبولين تضم اسمه ، تراه ما كان ليفعل ، أتراه أخطأ عندما اختار هذه الجامعة من بين كل الجامعات ، ما لجهوده الجدية في الاستذكار والتحضير لم تجدِ وتمنحه لقب الطالب فيها ، أيكون قاصراً بحق ، أيكون مستواه لم يرق لمثلها من جامعات ، أم أن الحظ عانده ، بأي طريقةً كانت ، فلم يكن ليجهد نفسه في التفكير في الطرق التي يتخذها القدر في معاندة المساكين ، كان يمشي الهوينا ، وهو يفكر في الطريقة التي سيذيع خبر البؤس ذاك على أسماع والديه ، اللذان ما عهداه يوماً إلا مجداً ، ومحققاً لكل ما أراد...
"ما فائدة الندم الآن ، أنت فشلت ، وسقطت كما يسقط النسر من أعالي السماء!"
تمتم بتلك الكلمات ، وهو يواصل دربه الذي لم يختره هو بإرادته ، بل رجلاه هما اللتان سلكتاه ، وقبل أن يعي وجد نفسه في ركنٍ من أركان منتزه المدينة ، الذي قليلاً ما يحضر إليه ، أو حتى يمر به ، لم يكن المنتزه مزدحماً في مثل هذا الوقت من الصباح ، فالناس إما نيام ، أو مغيبون في الأبنية والمصانع والحقول في أعمالهم ، مضى يشق طريقه بين الشجيرات الصغيرة التي تزين المنتزه ، ويتوه بين أشجاره وأزهاره ، كأنه للتو دخل عالماُ من الخيال لم يعهد له على الأرض وجوداً ، وقد يكون قد استرق بعينيه نظرة إلى محيط السماء الأزرق ، عله يجد نسره هنالك ما يزال يسبح في الفضاء الفسيح ، باحثاً لنفسه عن درب يسلكه ، لا يعلم كم من الوقت مكث وهو يتخبط بين أحلامه والواقع في ذلك المكان المبتدع ، قبل أن يجد نفسه جالساُ على أحد مقاعد الحديقة ، وقد خارت قواه ، لا من الجهد الجسدي وإنما من اختلاج الأسى في صدره ، تمنى لو استطاع التصريح عما يدور بداخله ببكاءٍ ، بل بنحيب ، لكن كبرياءه ، والطريقة التي رُبي عليها ، منعتاه من أن تسيل ولو دمعةٌ واحدة على خدوده التي لم ترتوي يوماً....
"تبكي... إنها تبكي..."
بضعُ كلمات خُيل له أن لسانه أطلقها ، أو أن صوتاً رخيماً بداخله غاص بها إلى إدراكه الذي تهاوي إلى السحيق ، لكن عقله رفض كِلا الاحتمالين ، فهو وإن كان في حالٍ يرثى لها ، مازال مسيطراً على أحاسيسه ، لذا استيقظ من تأمله ، وأدار برأسه جانباً ليشاهده ، ليست الكلمات فحسب ، بل مصدرها ، تلك الزهرة العَبِقة التي تجاوره والتي لا يدري كيف جاء إليها أو جاءت هي إليه ، لم يدري أكانت تخاطبه أم لنفسها كانت مخاطبةً ، غير معترفةً له بوجود ، فلم تكن تنظر إليه وإنما كان نظرها متجهاً إلى الأمام ، ورأسها منحنٍ إلى الأسفل قليلاً ، كم عجب لهدوء قامتها ، وسكون محيطها ، لكنه عجب أكثر للصوت الذي انبثق بعد ذلك ، مطلقاً سؤالاً لم يتوقع أن يُطلق.
"من التي تبكي؟"
لم يكن الصوت سوى صوته ، لم تكن تلك الحروف سوى حروفه ، ساسها في كلماتٍ وأطلقها تسبح في الهواء ، ويالبلاهته ، فقد أفسد الجو الهاديء والسكون الذي كان يحلق حول المكان ، توقع صفعةً يستحقها بجدارة ، أو كلمة توبيخٍ حادة تمرق صوبه ، ولكنها... لم تفعل ، لم تطلق يدها للريح لتهز جسده ، ولم ترفع صوتها كأنها لم ترد أن تفسد الجو اللطيف الذي عاد ليملك المكان بعد أن تلاشت موجات صوته وتشتت ذراتها في الهواء ، أو لعلها لم تجد فيه أهليةً تستحق مثل ذلك ، هكذا فكر ، لكنها... أيضاً ، لم تكن كذلك ، فبعد ثوانٍ معدودات ، مرت كقرون طوال أمامه ، استدارت قليلاً برأسها برفق وعفوية ، لتكشف عن حوراء يكاد يقسم أن الأمهات لم يلدن مثلها ، وقابلته تلك الابتسامة الوديعة ، والتي ما تكاد تلامس ملامحها ، والتي انتقلت لترسم على وجهه ابتسامة خجل ، ولتسري حمرةٌ داكنة على وجنتيه ، قبل أن يأتي ذلك الصوت الحاني ، ليمتع مسامعه بصوت دافيءٍ لكنه في نفس الوقت منخفض ، مما يزيده جمالاً على جمال ، ولترد على سؤاله.
"الأزهار" قالت وهي تحرك مقلتيها قليلاً صوب الجهة التي كانت تنظر إليها سابقاً ، لكنها لم تنزع عينيها عنه احتراماً "الأزهار تبكي"
لم يجد في نفسه استطاعةً إلا أن يتابع معها "ولم تبكي الأزهار؟ فأنا أراها ترقص على هبات الرياح."
"إنها.." وأغمضت عينيها ، كأنما ذهبت بخيالها بعيداً أو أضحت تصغي للغةٍ لم يستطع هو سماعها ، لغةٌ مجهولةٌ تتواثب كلماتها مع كل رقصة لتلك الأزهار المنتشرة حول الحديقة، والتي للتو بات يدرك كم كانت جميلة "إنها تبكي ، لأنها قد تزينت بأجمل أثوابها ، وأتت للطبيعة تنشر سناها ، لكن أحداً لم يأتي لأجلها ، ولم يأتي أحدٌ ليدلل مقامها ، فهي كجوهرةٍ تحت حجر ، لا يعيرها المارون اهتماماً"
وكأنه قد نسي الإعجاب الذي أوحته طلعتها ، أمام إعجابه بمنطقها الذي لم يعرف مثله في شخص يعرفه من قبل ، هكذا تحوم الذكرى في مخيلته عن لقائهما الأول ، ذكرى قد لا تكون بالدقة التي رغب لها أن تكون بها ، لكن المهم في الأمر أنها استطاعت ، ما يعتقد أن ليس يستطيعه أحد آخر ، ولا حتى نفسه ، أن يفعله ، أن تنقل عينيه من إسوداد الدنيا إلى تفتحها ، من كيد الهموم إلى واحة الخيال ، إلى عالمِ مُبدَعاتٍ يبتعد كثيراً عن عالم الموجودات الصارم.
لم تكن تلك الزيارة الأخيرة ، بل امتدت إلى زياراتٍ وجلساتٍ ، لم يُحصي لها عدداً ، فكان يوما الاثنين والجمعة أجمل أيامه ، حين تحمله رجلاه إلى المكان نفسه ، ليجدها ، دائماً هنالك ، متأملة ، دائماً هنالك قبله ، فكر أن يسألها متى تأتي إلى المكان ، لكنه لم يجد الشجاعة أبداًُ لذلك ، في بعض الأحيان كانت تأتي ببعض الشطائر التي صنعتها يداها الرقيقتان ، أو تأتي بكتاب ليتناقشا حوله ، فيها وجد مستودع أسرارٍ يبوح له بكل ما يؤرقه أو يضايقه ، لم يجد في نفسه غضاضةً أن يمنحها ثقته كاملةً ، وكانت كالدواء لجروحه ، تساعده ليبني لنفسه طريقاً بعد أن انهارت كل طرقه ، تضمد جراح جناحي النسر لكي يطير عالياً في السماء ، ويشمخ بهامته نحو الفضاء اللامتناهي...
يذكر مرةً من المرات أنها حدثته عن هندباءٍ بريةٍ جميلة وجدتها في ناحية من نواحي الحديقة ، تلك الحديقة التي باتت عالمها ، جنتهما ، بيتهما بعيداً عن بيتيهما الحقيقين ، ثم أخذته ليراها ، وقد أُعجب حقاً بها ، ولكن تراودت لخاطره فكرة ، حَولت نفسها إلى جملة تكونت على طرف لسانه قبل أن تكون لعقله فرصةُ التفكير في مغزاها.
"لماذا لا تقطيفينها ، وتحتفظي بها عندك لتتمتعي بهذا الجمال الخلاب دائماً"
ابتسمت له ، وقالت "لا... دعها لينعم الناس جميعاً بها ، فليس الجمال حِكراً على أحد ، فالكل لديه الحق بأن يُمتع ناظريه بها ، تماماً كما نُمتع ناظرينا بها الآن"
حينها ، خُيل له كأنما العالم الصارم في الخارج غزى عالمها ، أو عالمه هو فقط وهو يجيب "أخشى أن تأتي في يومٍ من الأيام ، لتجدين أن يداً قد سبقت يدك واقتطفتها ، بأن نفساً أبت إلا أن تستأثر دون البشر بهكذا رونقٍ رائع"
في الجُمعة التي تلت ، أتى إلى المكان ليجدها تبكي ، ليجد عبراتها ، كأنها قطرات الخُزامى تسيل على خديها ، ليجد عينيها اللتين طالما بثتا في نفسه الطمأنينة تذرفان ماء الحياة بكل حرارة ، عندما سألها مالخطب بعد أن زالت اللوعة التي اعترت نفسه ، أجابته بأن هل تتذكر تلك الهندباء البرية التي وجدناها في ناحية الحديقة ، فأجابها بأنه يتذكر ، لتجيبه بصوت متوازنٍ نسبياً ، بأنها ذهبت اليوم لتنهل من عطرها وتتمتع بمنظرها ، لكنها لم تجدها هناك ، لم تحتج لتكمل الفكرة ، فمخاوفه قد تحققت ، جاء من أعجبته تلك النبتة الغراء فقطفها غير مبالٍ بأحدٍ غيره ، لا يدري إذا ما كان ليلوم نفسه لأنه ذكر ذلك الاحتمال قِبَلاً ، لكنه كان يدرك في قرارة نفسه ، بأن عدم ذكر ذلك لم يكن ليمنع القدر من الحصول ، فليس الكل حريصاً على أن يكون الجمال بين الجميع مشتركاً ، فالإنسان تواقٌ لتملك كل ما برقت عيناه له ، والفرصة إن لم تُنتهز قد لا تعود أبدا.
لم تعكر تلك الحادثة صفو مجلسهما كثيراً ، فما إن أعلمها بخبر قبوله في جامعةٍ أخرى ، أقل مستوى من الأولى نعم ، لكنها لا تزال بمستوىً عالٍ ، وتناسب ميوله أكثر ، حتى تشققت أساريرها فرحاً ، لتكشف عن جمال فائق أكثر مما رآه من قبل.
بعد قبوله في الجامعة وانتظامه في الدراسة ازدادت مسئولياته وبالتالي قل وقت فراغه ، وانحصر لقائهما في يوم الجمعة فقط ، لكنهما لم يفقدا أيةً من الأواصر التي كانت تجمعهما أبداً ، لم يفقد المكان السحر الذي يتمتع به ، بل صار ذلك دافعاً له أكثر في اجتياز صعاب الأسبوع ليصل إلى يوم الجمعة ، ليصل إلى يوم اللقاء.
ولكن.... ككل شيءٍ في الحياة ، ككل حلمٍ خلاب يرفرف بآماله فوق المخيلة ، لا بد من نهايةً تختلف باختلاف الأحداث ، وإن لم تجرِ هذا النهاية حسب ما اشتهى هنا ، فقد جاء ذلك اليوم الذي وطأت رجلاه زاوية الحديقة ، لكن عينيه لم تجدا ما اعتادتا رؤيته ، من هول الصدمة أول مرة ، جلس ينتظر من الصباح حتى أفول الشمس عند المساء ، علها تأتي ، وجعل يدقق في التفاصيل ، لعله أخطأ اليوم والساعة أو المكان لكن دفتر مواعيده وساعته كانا يؤكدان له بأن المواعيد كانت دقيقة ، ثم غار في كنانة نفسه يبحث ، لعله قال ما يغضبها أو ما يحط من قدرها ، لكنه لم يجد شيئاً من ذاك ، فقد علمته حادثة الهندباء أن يزن كلامه وزناً قبل أن يطلقه ، بل عكس ذلك تماماً كان من المفروض أن يكون اليوم مميزاً ، فقد وعدته بأن تجلب شيئاً جميلاً لتريه له ، وفكر هو أن يهديها شيئاً آخر بدوره ، لماذا إذاً لم تأت؟ لماذا؟
انطلق يفتش في أنحاء المكان عساه يجدها في ناحيةٍ ما ، لربما ذهبت لتبحث عن زهور جميلة ونسيت نفسها وسط الجنة التي دخلت إليها ، أيمكن أن تكون قد مرضت اليوم ولم تأتِ... أيمكن أن.... أيمكن أن... ولكن كل آماله ومخاوفه لم تكن واقعية... أو أقلاً لم يكن لديه ما يؤكدها أو ينفيها.
مضى أسبوعٌ ، وأسبوعان ، وثلاثة ، خمسة.... حتى فقد العد ،أدرك خلالها مدى جهله بهذه الفتاة التي اختفت من حياته بنفس الغموض الذي دخلت به إليها ، لولا الذكريات الزاهية التي يحملها عن هذا المكان وعنها ، لقرر أن الأمر لم يعدُ أن يكون مجرد حلم سرابي مر به ، أو هلوسة أختلقها عقله ليُلهي نفسه عما ألم به من مُصاب ، لكن لا ، هو يتذكر جيداُ ، كانا هنا ، مفعمين بالحياة ، يتجاذبان أطراف الحديث ، من خلال الصمت والتأمل تارةً ، ومن خلال لغة الأنام تارةً أخرى ، نعم ، كان لهما وجود ، لم يكونا نكرتين في مجرة الحياة ، كان لهما دور ، وإن لم يتضح بصورة واضحة لكنهما كان لهما دور ، كانت هنا ، وستبقى هنا بذكرياتها ، ستبقى ما شاء الزمان أن تبقى...
في إحدى أمسيات شهر سبتمبر قرر التوقف عن ارتياد ذلك المكان ، قرر للذكريات المختزنة هناك أن تظل جميلة ، لا يريد أن يطردها بكثرة وقوف عند مكان حدوثها ، كأنما قررت نفسه أن تذعن للحقيقة أخيراً ، وأن تساير ما اختاره القدر لها ، فالذكرى ستظل له جميلة ، سيظل يتذكر كيف أن ذلك القرار الغير معتاد الذي اتخذته رجلاه بالدخول إلى الحديقة ، قد قاده إلى عالم كان يحتاج إليه حينها ، عالمٌ من البهجة والخيال كان يحتاج إليه ليواجه الظُلمة داخله ، ليقهر الخوف الذي تَمَلَكه ، يخيل إليه أحياناً بأنها... زهرته الفريدة ، كأنها لم تكن هنالك إلا لتلك المهمة ، التي ما إن أنجزت حتى غادرت المكان مسرعةً دون وداع فالوداع يثير في النفس أشجاناً قد لا تستطيع النفس تحملها ، ولكن... كم ودَ لو أنه قد تعرف عليها أكثر من ذلك.
كان يلقي نظرته الأخيرة على المكان تلك الأمسية ، يتودع منه كأنه مسافرٌ يتزود لسفره بالعدة ، بالذكريات الجميلة التي قد لا تعود ، لكنها تظل جميلةً ، تنير ظلمة الأيام إذا احتجبت شمس الحياة خلف غمام المصائب ، تظل جميلة كصاحبتها ، رَسَم على شفتيه ابتسامة خفيفةً ، ومضى يمشي مغادراً المكان ، غير نادمٍ على شيء.
بينما هو يسير، خطرت بباله فكرة ، أو بالأحرى مرت به ذكرى ، كأن المكان قد قرر ، في لحظة الوداع الأخيرة ، أن يبث في كيانه سيلاً دافئاً من المشاعر وهو يستعيد ، فرِحاً ، تلك الذكرى المميزة...
قد لا يكون قد سألها أي شيءٍ عن نفسها ، لكنها قالت له ، قالت له شيئاً مهماً كيف له أن يسمح لنفسه بأن تنساه ، لعل وقع المفاجأة جعله لا يميز بأن المعلومة قد وصلت له ، فدُفنت فترةً في أعماق الذكريات قبل أن تعود ، قالت له بأنها تًدعى (ريمان)... ريمان ، أيُ اسمٍ جميل هذا ، سيبقى يداعب مخيلته ما امتدت أيامه.