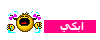بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم
أما بعد :
فقد كثر في الآونة الأخيرة الكثير من الكلام على مدارة ومداهنة الكفار وهذا ملخص لما تيسر لي جمعه عن التقية نفعني الله وإياكم بها معنى التقاة :
التقاة في اللغة مصدر مشتق، تقيته أتقيه، تقي، وتقية، وتقاء أي: حذرته.ويأتي المصدر أيضًا على تقاة([i])، كما في قوله تعالى: (إلا أن تتقوا منهم تقاة)([ii]).
قال الحافظ ابن حجر: "ومعنى التقية: الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير"([iii]).
وقال الإمام ابن تيمية: "والتقاة ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبى، فإن هذا نفاق، ولكن أفعلُ ما أقدِرُ عليه..
فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه، ولكن إن أمكنه بلسانه، وإلا فبقلبه، مع أنه لا يكذب ويقول بلسانه ما ليس في قلبه، إما أن يظهر دينه، وإما أن يكتمه، وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله؛ بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون، وامرأة فرعون، وهو لم يكن موافقًا لهم على جميع دينهم، ولا كان يكذب، ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه؛ بل كان يكتم إيمانه، وكتمان الدين شيء، وإظهار الدين الباطل شيء آخر، فهذا لم يبحه الله قط إلا لمن أكره، بحيث أبيح له النطق بكلمة الكفر"([iv]).
ومن هذين النصين يتضح أن معنى التقاة المشروعة كتمان الدين، وعدم إظهاره، وعدم الإنكار على الفجار والكفار باليد ولا باللسان؛ بل بالقلب، والدافع إلى هذا الكتمان والسكوت على المنكر هو الخوف الحقيقي من سطوة الكافرين.
وسبب نزولها يؤكد هذا المعنى ويجليه، حيث نزلت في عمار بن ياسر حين ضربه المشركون حتى باراهم في بعض ما يريدون، ونال من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر آلهتهم بخير([vi]).وهذه أقسام التقية، وشرط العمل بكل قسم، وحكمه فيما يلي:
القسم الأول: المداراة:
فقد عدّ قوم من باب التّقية مداراة الكفار والفسقة والظلمة، وإلانة الكلام، والتبسم في وجوههم، والانبساط معهم، وإعطاءهم، لكف أذاهم، وقطع لسانهم، وصيانة العرض منهم([vii])، ولتألف قلوبهم على الإسلام والاتباع.
وقد عقد الإمام البخاري - رحمه الله - في كتاب الأدب من صحيحه بابًا بعنوان: "باب المداراة مع الناس"([viii])، وساق تحته أثرًا معلقًا عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: "إنا لنكشِّر في وجوه أقوام، وإن قلوبنا لتلعنهم"([ix]).
وحديـث عائشـة - رضي الله عنها - أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: ائذنوا له، فبئس ابن العشيرة، أو بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام، فقلت: يا رسول الله، قلت ما قلت، ثم ألنت له في القول؟ فقال: "أي عائشة! إن شر الناس منـزلة عند الله من تركه، أو ودعه الناس اتقاء فحشه"([x]).
ومن هذا - وغيره - يتضح أن المداراة هي التلطف في المعاملة، ومحاذرة إثارة سخط الناس، بقصد جلب مصلحة شرعية، أو دفع مفسدة شرعية.
القسم الثاني: الكتمان والاستسرار:
وقد يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - الذي نقلته قبل صفحات - قَصْرُ معنى التقية على هذا القسم فحسب، حيث أشار إلى أن التقية ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي؛ بل هي كتمان الدين، وكتمان الدين شيء، وإظهار الدين الباطل شيء آخر([xi]).
وعلى أي حال فهذا القسم من أولى الأقسام دخولاً في معنى التّقية، ولكن لا يلزم من ذلك حصر معنى التّقية فيه.
القسم الثالث: إظهار الموافقة للمشركين على دينهم:
وهذا القسم هو أشد الأقسام وأخطرها، وفيه يتعدى الأمر مجرد السكوت والكتمان والاستسرار إلى إظهـار الدين الباطل، وموافقة المشركين عليه، وفي تعريف السرخسي للتّقية قال: "والتّقية أن يقي نفسه من العقوبة بما يظهره، وإن كان يضمر خلافه"([xii])، فقصر التّقية على هذا المعنى.
وقد أجمع العلماء قاطبة على أن الإنسان إذا واجه ضغطًا وتخويفًا وتهديدًا إن أصر على إيمانه، فلم يلتفت إلى هذا التخويف، وثبت على إعلان دينه، أنه فَعَل الأفضل، وإن قتل في هذا السبيل فهو شهيد([xiii])، وقد ترك الرخصة إلى العزيمة. ولكن يشترط للإكراه شروط:
الأول: أن يكون المهدد قادرًا على إيقاع ما يهدِّد به، والمأمور عاجزًا عن الدفع عن نفسه، ولو بالفرار و الهرب.
الثاني: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع عن فعل ما يؤمر به أوقع به ذلك.
الثالث: أن يكون التهديد بأمر فوري، كأن يهدده بالقتل، أما لو قال: افعل كذا، وإلا ضربتك غدًا لم يكن مكرهًا، إلا إذا كان الزمن المحدد قريبًا جدًّا، فيكون في حكم الأمر الفوري.
الرابع: ألا يظهر من المأمور المكره ما يدل على نوع من الرضا والاختيار والموافقة القلبية([xiv]).
وقال - رحمه الله - في تعليق له على موقف الإمام أحمد ورفضه التّقية لما يترتب عليها من التلبيس على الجهال: ".. أما أولو العزم من الأئمة الهداة، فإنهم يأخذون بالعزيمة، ويحتملون الأذى ويثبتون، وفي سبيل الله ما يلقون، ولو أنهم أخذوا بالتّقية، واستساغوا الرخصة لضل الناس من ورائهم، يقتدون بهم، ولا يعلمون أن هذه تقية.
وفي الخاتمة هذه بعض الفروق بين تقية اهل السنة والفرق الضالة :
الفرق الأول:
أن التّقية عند أهل السنة استثناء مؤقت من أصل كلي عام، لظرف خاص يمر به الفرد المسلم، أو الفئة المسلمة، وهي مع ذلك رخصة جائزة (*).
أما الرافضة فالتّقية عندهم واجب مفروض حتى يخرج قائمهم، وهي بمنـزلة الصلاة، حتى نقلوا عن الصادق([xvi]) قوله: "لو قلت إن تارك التّقية كتارك الصلاة لكنت صادقًا"([xvii]).
فالتّقية في المذهب الشيعي أصل ثابت مطرد، وليست حالة عارضة مؤقتة.
الفرق الثاني:
إن التقية عند أهل السنة ينتهي العمل بها بمجرد زوال السبب الداعي لها من الإكراه ونحوه، ويصبح الاستمرار عليها - حينئذ - دليلاً على أنها لم تكن تقية ولا خوفًا؛ بل كانت ردَّة ونفاقًا.
وفي الأزمنة التي تعلو فيها كلمة الإسلام، وتقوم دولته، ينتهي العمل بالتّقية - غالبًا - وتصبح حالة فردية نادرة.
أما عند الرافضة، فهي واجب جماعي مستمر، لا ينتهي العمل به، حتى يخرج مهديهم المنتظر الذي لن يخرج أبدًا.
الفرق الثالث:
أن تقاة أهل السنة تكون مع الكفار - غالبًا - كما هو نص قوله تعالى: (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً).
وقد تكون مع الفساق والظلمة الذين يخشى الإنسان شرهم، ويحاذر بأسهم وسطوتهم. أما تقية الرافضة فهي أصلاً مع المسلمين.
وهم يسمون الدولة المسلمة "دولة الباطل"([xxi])، ويسمون دار الإسلام: "دار التّقية"([xxii]) ويرون أن من ترك التّقية في دولة الظالمين فقد خالف دين الإمامية وفارقه([xxiii]).
بل تعدى الأمر عندهم إلى حد العمل بالتّقية فيما بينهم حتى يعتادوها ويحسنوا العمل بها أمام أهل السنة.
الفرق الرابع:
أن التقاة عند أهل السنة حالة مكروهة ممقوتة، يكره عليها المسلم إكراهًا، ويلجأ إليها إلجاء، ولا يداخل قلبه - خلال عمله بالتقاة - أدنى شيء من الرضى، أو الاطمئنان، وكيف يهدأ باله، ويرتاح ضميره، وهو يظهر أمرًا يناقض عَقْدَ قلبه؟
أما الرافضة، فلما للتّقية عندهم من المكانة، ولما لها في دينهم من المنـزلة، ولما لها في حياتهم العملية الواقعية من التأثير، فقد عملوا على "تطبيعها"، وتعويد أتباعهم عليها، وأصبحوا يتوارثون التمدح بها كابرًا عن كابر.
وإذًا فالتّقية والاستسرار هما حالان عارضان، يحتاج إليهما الفرد المسلم، والجماعة المسلمة، في أزمنة الغربة المستقرة، وفي حالة ضعف الدعوة، أو في ظروف معينة، وهما استثناء من الأصل الذي هو الجهر، والإعلان، والوضوح، وإقامة الحجة، والله أعلم.
(1) انظر: لسان العرب (15/402).
(2) سورة آل عمران، الآية: 28.
(3) فتح الباري: (12/314).
(4) منهاج السنة: (3/260).
(5) سورة النحل، الآية: 106.
(6) سبق تخريج الحديث، من حديث ابن عباس في اضطهاد المستضعفين وضربهم حتى ليقر أحدهم بأن الجعل إلهه من دون الله، مما يبلغون من جهده، وذلك في الكتاب الأول، الفصل الثاني: من مظاهر الغربة. الاضطهاد، وقال ابن حجر في طرق هذا الحديث: "وهذه المراسيل تقوّى بعضها ببعض" الفتح (12/312).
(7) انظر: مختصر التحفة الاثني عشرية لعلامة العراق محمود شكري الألوسي، ص (288).
(8) صحيح البخاري (7/102).
(9) رواه البخاري تعليقًا غير مجزوم به في: 78- كتاب الأدب، 82- باب المداراة مع الناس، (7/102)، قال: ويذكر عن أبي الدرداء.
- ورواه أبو نعيم في الحلية: 35- أبو الدرداء (1/222) من طريق عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان، عن خلف بن حوشب قال أبو الدرداء، فذكره.
وقال ابن حجر: فيه انقطاع بين خلف وأبي الدرداء، ولذلك لم يجزم به المؤلف. تغليق التعليق (5/103)، وانظر: الفتح (10/528).
وعزاه ابن حجر لأحمد بن مروان الدينوري في كتاب المجالسة من طريق الأحوص بن حكيم، عن أبي الزاهرية، قال: قال أبو الدرداء... وقال: في إسناده ضعف. التغليق (5/103).
وعزاه أيضًا لابن أبي الدنيا، وإبراهيم الحربي في غريب الحديث، والدينوري في المجالسة من طريق الأحوص عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير. عن أبي الدرداء.
انظر: التغليق (5/103) الفتح (10/528).
والأحوص بن حكيم: ضعيف الحفظ، انظر. التهذيب (1/192)، التقريـب (1/49).
وأبو الزاهرية هو حدير بن كريب الحضرمي: صدوق. انظر: التهذيب (2/218)، التقريب (1/156).
فهـذا الإسناد ضعيف أيضًا.
ثم ساقه ابن حجر بإسناده إلى فوائد أبي بكر المقرئ من طريق المسيب بن واضح، حدثنا يوسف بن أسباط، عن كامل أبي العلاء، عن أبي صالح قال: قال أبو الدرداء..
قال: وكامل ضعيف، وقال: وهو منقطع. التغليق(5/104)، الفتح (10/528). والمسيب بن واضح صدوق له مناكير. انظر: الميزان (4/116)، المغني (2/659). ويوسف بن أسباط: وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم "يحتج به"، وقال البخاري: كان قد دفن كتبه فكان لا يجيء بحديثه كما ينبغي. انظر: الميزان (4/462)، والمغني (2/761).
وكامل هو ابن العلاء التميمي، أبو العلاء: صدوق يخطئ. انظر: التهذيب (8/409)، التقريب (2/131).
وأبو صالح، لعله مينا مولى ضباعة، لين الحديث. انظر: التهذيب (12/132) التقريب (2/437).
فهذا الإسناد ضعيف.
ولكن هذه الطرق يتقوى بعضها ببعض، إذ إنها جميعًا قابلة للانجبار، فيصير الأثر - بمجموعها - حسنًا لغيره.
(10) رواه البخاري في: 78- كتاب الأدب، 82- باب المداراة مع الناس، (7/102).
38- باب لم يكن النبيصلى الله عليه وسلم فاحشًا ولا متفحشًا، (7/81).
48- باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب (7/86).
- ومسلم في: 45- كتاب البر والصلة والآداب، 22- باب مداراة من يتقى فحشه، برقم (73)، (4/2002).
- وأبو داود في: 35- كتاب الأدب، 6- باب في حسن العشرة، برقم (4791)، (5/144).
- والترمذي في: 28- كتاب البر والصلة، 59- باب ما جاء في المداراة برقم (1999)، (4/359)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
- والنسائي في عمل اليوم والليلة: 90- كيف الذم؟ برقم (237)، ص (245)، بلفظ: مر رجل برسول اللهصلى الله عليه وسلم فقال: بئس عبد الله وأخو العشيرة، ثم دخل عليه، فرأيته أقبل عليه بوجهه، كأن له عنده منـزلة، برقم (238)، وفيه: فلما دخل انبسط إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- وأحمد في المسند (6/38).
(11) منهاج السنة (3/260).
(12) المبسوط (24/45).
(13) انظر: تفسير القرطبي (5/188) وأحكام القرآن لابن العربي (2/1167)، وقال ابن حجر: "قال ابن بطال: اجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجرًا عند الله ممن اختار الرخصة، وأما غير الكفر، فإن أكره على أكل الخنـزير، وشرب الخمر- مثلاً- فالفعل أولى.
وقال بعض المالكية: بل يأثم إن منع من أكل غيرها، فإنه يصير كالمضطر إلى أكل الميتة، إذا خاف على نفسه الموت فلم يأكل. الفتح (12/317).
(14) انظر: فتح الباري (12/311)
(15) طلائع تحقيق المسند للشيخ أحمد شاكر (1/98- 99).
(*) قال سماحة الوالد الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، حفظه الله تعالى: يصار إليها عند الحاجة، أو لحصول المصلحة الراجحة. حرر فى 29/3/1413هـ.
(16) هو جعفر بن محمد الصادق، الإمام الصدوق الفقيه، وهو منـزه عما تقولوه عليه، أو ألصقوه به من الأكاذيب. انظر في ترجمته: التهذيب (2/103)، التقريب (1/132).
(17) كتاب السرائر لابن إدريس، ص(479)، ومن لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي (2/80)، ووسائل الشيعة للحر العاملي (7/74).
(18) كتاب أصول الكافي للكليني (2/217)، والوسائل للعاملي (11/460).
(19) أصول الكافي للكليني (2/217)، والوسائل (11/460).
(20) إكمال الدين لابن بابويه القمي، ص (355)، إعلام الورى للطبرسى، ص (408)، وسائل الشيعة (11/465-466)، وغيرها من كتب الرافضة.
(21) بحار الأنوار للمجلسي (75/412).
(22) إكمال الدين لابن بابويه القمي، ص (355)، إعلام الورى للطبرسي، ص (408).
(23) كتاب بحار الأنوار للمجلسي: (75/421).
(24) وسائل الشيعة للعاملي: (11/466).
(25) جامع الأخبار لابن بابويه القمي، ص (110)، وغيره.