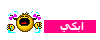(2)
تمهيد:
لكل إنسان حكاية يغزل خيوطها مع رفاق درب تابعوا أم لم يتابعوا مسيرة الحياة معه. وحكايتي أنا حكاية أناس من دمشقي الحبيبة، ظل نبضهم حياً في خاطري. رغم غيابهم تركوا بصماتهم على خط الحياة تأرجحوا مع الأيام، لكنهم لم يتقهقروا أو يطأطئوا.
أناس حارتي، بنات حارتي، شباب حارتي، حملوا قيماً ورواسب، ومفاهيم أصلتها بأصالتها الحياة، وغيرتها بتغيراتها الحياة. فإن وجدت نفسي بينهم ووجدت نفسك معهم فلأننا نعيش أفراحهم وأتراحهم، ويعيشون أفراحنا وأتراحنا، فما زالت الدنيا خيرة وبخير ومن لا يقع لا يقف ولا يصل، هكذا مات بعضهم واقفين.
قالوا:
-حملت سلمى من اسمها بعضاً من تكوينها النفسي والخلقي بنظرة متشوقة نحو المتغيرات التي تحيط بها. توقفت في محطات متلونة تركت في مخيلتها الفتية آثاراً عميقة، ونمنمات مثيرة، وذكريات ثرة، كمرتها في فؤادها.
إذا أطل الماضي بأبعاده الحانية أو الداكنة، تبسمت رضى لحياة عاشتها بين أب وأم عاشقين، حاولا أن يرضيا غرورها بعيش هنيء موار.
قالت نساء الحارة:
-ليست سلمى جميلة كما الجمال بتقاطيع مثالية متناسقة، وأنف دقيق شامخ، وفم مغرٍ وعينين حوراوين.
وقال شاعر:
-كانت سلمى أقوى من الجمال.. حضور حلو، أنفة، وشخصية متميزة. ملكة نفسها وقال آخر:
-إذا أرادت سلمى، صممت، توهجت كشرارة، لم تنزلق في وحل، ولم تقف على قدم واحدة. تفتحت في أرض صلبة مليئة بعروق الذهب.
قالت الأم:
-لسلمى نظرة شفافة تخترق القلب. تقرأ خطوط الزمن في وجوه أناس الحارة. سلمى مزيج من تواشج الضباب والشمس والمطر. خلقت في يوم شتائي عاصف يتلاعب على شاشة الحياة.
كبرت سلمى وسجلت سلمى على دفتر صغير ملامح شخصيات آسرة عن الحارة، بسيطة غنية، ظلت متألقة في ذاكرتها.
"جعلتني دمشقيتي قريبة من الهواء النقي الذي يتسلل من جبل قاسيون عبر النوافذ المشرعة نحو الشمس. بيتنا واسع فسيح ينبض بالحب. يرى السماء الزرقاء بتغيراتها الأربع. في الشتاء تمتلئ الدار ثلجاً وخيراً".
أنام في غرفة نافذتها عالية مشرقة مطلة على حارة مغلقة بمستطيل انكسر أحد أضلاعه يلتصق جداري بجدار أبوي، اسمع دردشتهما وجدالهما وحوارهما.
صوت أمي:
-إن شاء الله ما في إضراب غداً.
يرد أبي:
-نصف السنة إضرابات.
أخي الكبير هشام الذي يُذبح خروف العيد بين رجليه يجر جسده جراً إلى المدرسة "الفرير"Frere وهو يلعن تقاليدها الصارمة، ونظامها القاسي، والساعة التي دخلها.
كما علق الأوسط كرة القدم. أضحت هوايته كارثة حقيقية لعائلة امتهنت القضاء أباً عن جد.
ما كنت لاهية عما يقلق بال والدي، فأبي أمين جمرك دمشق تحدر من صلب علماء تركوا بصماتهم واجتهادهم على الفقه والعدل.
بين اليقظة والحلم يموت الحوار يقترب من الهمس الدافئ.
يحلو لأمي. عروس بيروت، سليلة عائلة عريقة فيها، أن تلتم على أولادها، وأن تقاطع كل متحدث كي تحكي عن أخيها المغترب الذي هاجر إلى إفريقيا في عام ألف وتسعمئة وخمسة وعشرين.
-وهناك- تعيد السيرة ذاتها- أصبح اسمه محمد الفاتح تاجر للحرير والعاج من أكبر التجار. في يوم صحو آخر من أيام نيسان لحقه أخي الأصغر. كان شمساً حقيقية توهجت في البيت. وعندما حمله بحر بيروت، أحست أمي بتسرب الدم الغالي من أوردتها، فأنّتْ، ومكثت تئن طوال حياتها وحتى مماتها.
دفعتني يوماً، وأنا في مطالع قدرتي على القراءة والكتابة أن أخط أول رسالة إليه، فما كانت تفك سوى أحرفٍ من أسماء أولادها التي أغلقت دنياها عليهم.
قرأت لها بعض الأسطر القليلة. كتبتها بحروف كبيرة مائلة عن السطر ملأت الصفحة. فبكت.
أمدني بكاؤها برصيد معنوي عاطفي جسّم كبريائي. ربحت جولة أولى، ولما أتجاوز الثاني ابتدائي. تغلبت على مفردات صعبة سعّرت أوار عطشي إلى عالم زاخر بالحكايا. رحت أنبش عنها في الكتب الصفراء والبيضاء والمجلات وبين مزق الزيبق ودليلة. نسيت حالي، ونسيني الجميع.
كنت أطير فرحاً بقراءاتي. أعاقب دليلة وأغضب من الزيبق. وأعجب بنجيب محفوظ.
ضم بيتنا الكبير أربعة صبيان وثلاث بنات. توأمان جاءتا الدنيا قبل مجيئي أنا إليها، ما لبثا أن أغلقتا الباب على أسرارهما، ولم نلتقط منهما سوى الابتسامة مرسومة على الشفاه الراضخة لقانون العائلة الصريح: لا فضائح.
يرفض عقلي الصغير انطواءهما تحت هيمنة العرف السائد وقيده الذهبي.. "لمها" الثانية قد فارع، وقامة هيفاء، بهيجة، صغيرة كبيرة، سرعان ما صارت أماً لأربع بنات ولما تتخط التاسعة عشرة.
كانت نهمة للحياة تهبج الأفراح من وجه النسمة. تزورنا كل شهر إذا سمح أبو البنات. تقول العائلة متبرمة:
-ضحك القدر في وجه التوأم هدى عندما تزوجت نبيلاً ينتمي إلى أسرة باشوات عريقة تسلسلت عبر مراتب سلك الجيش. وبعد أشهر حملها زوجها إلى مدينة اسكندرون، لتعيش مع أهله في بيئة أرستقراطية تجيد اللغات الأجنبية وأصول الاتيكيت.
زياراتها إلى الشام محدودة مقننة وموزعة على المواسم والأعياد.
كانت هدى جميلة شقراء، مرهفة تحب الموسيقى ماهرة في حياكة الصوف والتطريز.
تردد أمي:
-أناملها شمع، ويداها ذهب.
ذات مساء خريفي. امتلأ البيت بصديقات أمي، وجاءت "مها" تجر خلفها بناتها الأربع. انزوى أبي بعيداً في غرفة الجلوس يقرأ (طه حسين) معجباً.
رن جرس الباب رنات متسارعة نزقة تحركت "مها" نحوه. أوقفتها والدتي بزجرة من عينيها ثم دفعتها إلى الغرفة حيث الوالد. مشت هي تستطلع أمر القارع المتعجل.
طال الحديث خلف الباب.. علا صراخ مبهم. عادت أمي إلينا صفراء مضطربة. همست في أذن أختي:
-هو.. وأضافت نكدة. صبري أفندي بسلامته.
فهمنا يومئذٍ لم جاءتنا. كانت حردانة.
لا تفصح أمي عادة عن مرادها بوضوح. ترمز وعلى الآخرين أن يفهموا ويستجيبوا.
هو يعني: "صهري" الذي أتى محارباً يبغي استرداد امرأته وبناته.
علقت أمي بحياء:
-قال يحبها.. والله لا يوفر كلبة في الشارع، ولا يتورع عن قطة.
وقفت "مها" قرب الباب حائرة. انهمرت دموعها على خديها. أطرق والدي محزوناً، كور حبات السبحة الصدفية في كفه وتعوذ من الشيطان الرجيم.
-يا بنتي. البيت بيتك. والبنات بناتك، شرفك. أعرف أنه قذر، ولكن ما العمل؟ اذهبي معه الآن وسنرى.
صدرت عن أخي هشام حركة غضب، ألقى كتاب الفرنسي جانباً، همّ، ولكنه أحجم.
لمحت دموع "مها" وأنا ألملم زهرات الياسمين البيضاء عن الطاولة.
لحقت بالمرأة المقهورة قبل أن تغادرنا إلى بيتها الذي لم تحبه أبداً.
شددتها من ثوبها المخملي الخمري أستبقيها. تلكأت لحظة، ثم مسحت على شعري المضفور كإكليل فوق رأسي وقبلتني. قبل أن تغلق الباب خلفها بصمت غرست نظرة مبهمة في عيني، ثم حملت ابنتها الرضيع وغادرت مع بناتها.
لم يودعها أحد، لم يسمح والدي بذلك، كلمته مطلقة.
لملمت أمي فناجين القهوة المبعثرة على الطاولات، تشاغلت بتنظيم البيت نبرت دون تمهيد وبصوت مبحوح:
-والله ما أحببته يوماً. نصيب. آخر حركاته، كلب ذئبي مرعب.. ينبح في أذن المصلين، وأين وضعه؟ على السطح المطل على الجامع يا خجلنا من الناس..
كلب ابن كلب أنهت رأيها، ثم أطبقت شفتيها.
انطوى شهر تشرين الأول. وتبعه الثاني. هفهف برد كانون، عكر سكينتنا خبر مفاجئ سافرت أختي إلى أرض بكر مجهولة في شمال سوريا. ضب "صبري أفندي" الأثاث الأنيق الفاخر وباعه بالجملة كي يسدد ديونه بعد أن خسر نصف أمواله على موائد القمار في نادي الصفا.
في صدر أمي بئر عميقة لأسرار الجيران الأوادم.
يفصلنا عنهم من كتبية المطبخ جدار رقيق من خشب الجوز رصفت على رفوفه الطناجر النحاسية المتلألئة.
في تمام الثامنة، يخرج الرجال إلى أعمالهم.
تدق جارتنا الطويلة النحيلة كقصبة صيد السمك دقات منغمة على الجدار:
-صباح الخير أم هشام.. راح جارنا الله معه.
تتكتك المرأتان بقلب مفتوح، تكشفان همومهما المبثوثة في خبايا الأضلع عبر الفاصل الهزيل الذي يمنع سقوط العين عندما تتعرى الأفئدة.
مشكلة جارتنا أنها تلد بناتاً، ويسكنها هلع من شبح الطلاق. تتوهم بأن جذورها باتت على البلاط، ولن يشفع لها حسن سلوكها ولا سمعة أبيها كأستاذ محترم في الرياضيات.
ينغل بيتنا بالأولاد، أمي ولود، والعائلة ولود تحمل أوسمة الخصب المبكر. البنت عربية، مساعدة أمي، حولاء جاءتنا من تل منين، تنظف، ترفو الجوارب، تكوي وأحياناً تساعد الغسالة أم حسن التي تأتينا مرة كل أسبوع من جبل الأربعين حاملة سطلاً فارغاً. كانت أمي في آخر النهار تملأ السطل مما طبخت، وتحمله أم حسن إلى أولادها اليتامى.
تردد باكية:
-شاب والله، يا أم هشام، مثل الوردة، أحسن طيان في المهاجرين ما مثله شغّيل. سقط عن السقالة صباح العيد وماردّ النفس. نصيب. تسأل أمي جزعة:
-وما له تعويض، معاش؟
-ما له!
كان بيتنا عامراً دوماً بأشهى الطعام، يأتينا سمك طازج من طبريا توزع أمي منه على الجيران الملاكة، وهم بدورهم يصبون علينا خيرات أراضيهم في الغوطة. تبدو والدتي مزهوة بكرمها، راضية عن عيشتها.
لم تخفف السهرات القليلة المختلطة من إدمان أبي على مقهى المهاجرين في آخر خط الترام. يسعى ماشياً مشية عسكرية يعب الهواء عبات مسموعة بزفير وشهيق منتظمين، وعندما يصل البيت يأخذ مكانه على الكرسي القش ذي المسندين. يرمي سبحته على الطاولة المعدنية المدورة، ويطلب شاياً، ثم يتأمل دمشق من إطلالته المشرفة منتشياً داعياً:
-الله يحفظك يا شام، ويخلصك من الأجنبي.
كنت معجبة بأبي.. وما دام في البيت كنت لا أكاد أفارقه. أنتظره عصراً قرب الباب أقبل يده، وأظل ممسكة بها. وحتى على سجادة الصلاة كنت أبربر معه بكلمات لا أفهم معناها تعلمتها لا من تلاوات أبي بل من دروس الراهبة الإيطالية في المدرسة. يضحك، ومن خلف ظهري يتضاحك إخوتي، وتقف أمي باسمة..
تشبه الحارة في المهاجرين نادياً نسائياً. تنزين النساء جمعة الاستقبال أجمل زينة وتبدأن منافسة شيقة بينهن ومباهاة في الملبس والمأكل والضيافة والتسريحة.. يدور حديث حول الموضة، والسفور، ورائدات السفور اللواتي تجرأن وتحدّين فنزعن المنديل الأسود عن رؤوسهن. تعود الواحدة منهن مفعمة بالقصص والأشعار وغرائب الحكايا لتسلي العائلة.
يقايضني أخي سامي على قطع الحلوى فيحل لي مسألة الحساب. جاءني يوماً مستضعفاً:
-سلمى حبّابة أنت.. أريد معروفاً، أنا بحاجة إلى كتاب التاريخ الطبيعي.
أرامقه مستفهمة.
-هلا استعرته لي من صديقتك "زينة". تكبرني زينة، رفيقتي في المدرسة، بأعوام ثلاثة. هي جميلة بيضاء نظيفة الرائحة.
قلت: لمَ لا.. تحب أمها أمي وتسّر لها كوامن أشجانها وحتى دقائق حياتها الزوجية، ورغبتها المكبوتة بين أربع حيطان ضم ابنة حماها العانس فيما زوجها يقضي معظم وقته في الضيعة. مع من؟ لا تدري.
ألم تسألها مرة أن تقسم على المصحف الشريف بأن تحفظ سرّها إذ تتمنى الموت لتلك العانس الشمطاء؟ أو تجد وسيلة.
ارتديت ثوباً سماوياً مطرزاً بخيوط حريرية حول القبة المدورة، فصلته لي خياطة الحارة الماهرة " مسرة خانم".
تقول أم زينة عنها:
-من تضاهيها؟ ولا واحدة. فنانة، ترسم، وتفصل، وتجدل الخيوط ببعضها، وتصنع زنانير رائعة.
أجلستني زينة على الأريكة الطويلة المستورة بقماش مورد مكشكش. تأملت أظافرها المقصوصة، ثم ابتسمت بلطف، غابت لحظة وعادت بالكتاب. وضعته أمامي:
-تفضلي.
قلبته. صور حيوانات مألوفة وغير مألوفة من قارات بعيدة. حملتني عوالمه وألوانه إلى بلاد شاسعة إلى ما وراء حدود دمشق وبيروت التي لا أعرف غيرها.
عدت فرحة بما أحمل. سلمت سامي الكتاب، لمحت بريقاً لامعاً في عينيه، وسعادة آسرة غمرت وجهه البرئ المزغب وهويتفتح للحياة.
غيرت مجبرة مدرستي الأجنبية بتحريض من أعمامي خوفاً منهم على عقيدتهم من الإنشراخ. وما أسلموا أعماقهم في حقيقة الأمر إلاّ إلى الغيرة.
اعتبرت تلك النقلة من المدرسة الإيطالية بمثابة عقاب لي. هبطت عشر درجات ودخلت دوامة الأزورار في المدرسة الحكومية والخوف من المسطرة، والقرفصة على الأرض حتى تتيبس الأقدام. أضعت متعة الغناء الجماعي بمرافقة الراهبة على أنغام البيانو.
بعد لأي متعثر بدأت أتأقلم مع لداتٍ في مدرسة "خولة الكندية" بالمهاجرين. في هذه المدرسة توثقت عرى الصداقة بيني وبين زينة وليلى وناديا من بنات الحارة التي أضحت مرتع لقاءاتنا البريئة وحلم أيامنا.
أعدت كتاب التاريخ الطبيعي إلى صاحبته وأنا سعيدة.
في طريقي إلى المدرسة صباحاً رأيت زينة كحمامة يرفرف فوق جبينها شريط أبيض. لحقت بها. هربت مني. قرأت في عينيها شيئاً غريباً، بغيضاً، انقلاباً استوفز كبريائي وبنى سداً منيعاً بيننا، أمعنتْ في أزوارها، تعمقت القطيعة فقررت إذلالها. أغفلتها من حياتي وتفكيري، وعقدت صداقة مع ليلى.
عدت من المدرسة إلى البيت في الرابعة بعد الظهر. رأيت الحطب مرمياً، والحطابون ينيخون جمالهم للراحة. شممت رائحة شياط.
بادرتني نظرة من أمي ملبدة بالغضب. لاحظت رعشة خفيفة في شفتيها. ردت الباب بنزق:
-عجلي عجلي غيري صدارك.. عندما أم زينة.
-أم زينة؟ وما شأني أنا؟
امتثلتُ. فتحتُ باب الصالة فضرب الحائط. هاجمتني رصة لئيمة تعلو شفتي جارتنا الرقيقتين مضمومتين على ازدراء. لمحت بين يديها كتاب التاريخ الطبيعي الذي لابنتها. فجأة رمته من يدها على الطاولة قرب فنجان القهوة الذي لم تمسه ورددت مرتين: