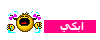المشاركة في نظام حكم كفر
لقد كمل الدين وتمت النعمة. فلا تبديل لكلمات الله. قال تعالى: ] وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ[. وإنه لمن فضل الله على عباده أنه أكمل لهم دينهم وأتم عليهم نعمته، وحرز لهم القرآن وحفظه من أن تطاله يد التغيير والتبديل . قال تعالى: ]إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ[. وقد حفظه الله ليكون حجة للناس أو عليهم حتى قيام الساعة.
ولما كان الرسول r هو أُذُنُ الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء إلى هذه الأرض، وجب على المسلمين أن يقوموا بإرث النبوة خير قيام: يستمسكون بالقرآن ، ويعضون على السنة بالنواجذ كما أُمِروا ، ويكونون على ما كان عليه الرسول r وصحابته. وقد جاءت الأدلة متضافرة على ذلك.
ولما كان المسلمون، عند حملهم للدعوة، يحتكون بباقي الأمم، ويعرضون عليهم دينهم الحنيف، دين العقل والفطرة، فإنه بالمقابل، كانت الأمم الأخرى تعرض، ولو من باب الدفاع عن نفسها، ما عندها على المسلمين، وكان بعض المسلمين يتأثرون أحياناً ببعض ما عند غيرهم من غير أن يشعروا. ويكون لهذا أثره السلبي على الفهم والدعوة. ولكن ما أن تمضي فترة حتى يتنبه علماء المسلمين، الذين جعلهم الله منارات وصُوىً يعرف بهم الحق ، لذلك، فينفوا عن الدين ما خُلِطُ به مما ليس منه، ويمنعوا التحريف، ويبطلوا التزييف، فيعود للدين مضاؤه. وعليه فقد كان المسلمون يتنقلون ما بين خير وشر. إلى أن جاءنا الشر الذي نحن فيه . فكيف الخلاص؟.
إن حالتنا اليوم تستدعي منا العودة إلى أسباب صلاح أول الأمر لنعيد إلى الإسلام سيرته الأولى.
وحتى ننقي الإسلام من كل شائبة، وننفي عنه كل تحريف، ونبطل كل تزييف: علينا أن نتخلص من تلك العقلية الفاسدة التي أورثنا إياها الغرب، تلك العقلية التي تجعلنا نقيس أمور الدعوة بمقاييس المنفعة والهوى، فما وافق الهوى أخذناه، وما خالفه تركناه، ومن ثم نتأول النصوص الشرعية بالشكل الذي يتوافق مع آرائنا. ويأتي استشهادنا بالنصوص للدلالة على صحة ما رأيناه. ان العقلية الإسلامية الصحيحة تقوم على أن الأمر لله وحده، فلا يجوز لنا أن ندخل في فهمنا لحكم الله أمزجتنا ولا ميولنا، ولا أن نحكِّم فيه أهواءنا، ولا أن نجعل خوف الأعداء ، أو بعد الناس، أو عدم رغبة الحكام في الدين، أو الملابسات والظروف، أو عدم ظهور مصلحة، مبرراً لحَمَلَةِ الدعوة للتخفيف من الحمل والتسهيل على المسلمين. ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير، يعلم حقيقة ما طبع عليه البشر، وما يحتاجون إليه، وما يستطيعونه، والواقع الذي يعيشون فيه، ومن هم الأعداء، وكيف يجب التعامل معهم و ...
وطريقة الاجتهاد الصحيحة والوحيدة، والتي سبق أن بينّاها، تقوم على فهم الواقع الذي يراد معالجته أولاً، ومن ثم معالجته بالنصوص الشرعية بحسب دلالاتها ، فتؤدي إلى معرفة حكم الله ، دون سواه، في هذا الواقع. أي كأننا نقول، عندما نسير بحسب هذه الطريقة: إنّ واقعنا الذي نعيشه، بما فيه من ملابسات وظروف، وما فيه من شدة وقسوة، وما يتوخى فيه من مصلحة: هذا هو حكم الله فيه. وفي هذا يقول الله تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[.
ويقول تعالى: ]وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً[.
إن الفارق بين تينك العقليتين هو الذي أدى إلى هذا التباعد في فهم الأحكام التي يراد معالجة أوضاع المسلمين بها.
على أن العقلية المتأثرة بالفكر الغربي أدت، فيما أدت، إلى تعطيل بعض النصوص القطعية، والعدول عنها إلى غيرها مما لم يأت به دليل، تحت حجة الظروف والملابسات والمصلحة، ومنع الضرر ... فحكم الربا مثلاً هو التحريم القطعي، وبلفظ صريح لا يحتمل التأويل، وخالٍ من التعليل. وقد جاء الواقع والظروف والملابسات، وجلب المنافع، ودرء المفاسد ليؤثر فيهم ويجعلهم يخرجون بحكم مغاير، وهو جواز التعامل بالربا.
وقد قامت جماعات على هذه العقلية، وخرجت بأحكام لا سند لها من الشرع، بل تخالف الشرع مخالفة حادة. وذلك عندما نادت بأن الديمقراطية من الإسلام، في حين أنها نقيض له كما بيّنا، وأن المشاركة في الأنظمة الجاهلية جائزة شرعاً، وأنها السبيل الوحيد المتوفر الآن أمام الحركة الإسلامية العاملة للوصول إلى الحكم بما أنزل الله. مع أنها تعارض آيات القرآن وسُنّة الرسول r معارضة تامة.
ونحن عندما بيّنا فساد فكرة التدرج في تطبيق الإسلام أو الدعوة لها، نكون قد بيّنا في الوقت نفسه، فساد ما تعلَّق بها من أفكار، كفكرة المشاركة. ولكننا في هذا الموضوع مضطرون للوقوف قليلاً أمام هذه الفكرة لرد ما عَلِق بها من شبهات. وحتى لا يبقى لمتقوِّل بعد ذلك عذر.
ونحن نعلم أيضاً أنه ما لم تصلح عقلية هذه الجماعات في فهم الشرع، فلن تنفع معهم نصيحة. لأننا إذا استطعنا أن نقنعهم بفساد فكرة المشاركة في الحكم، وهم على هذه العقلية، فإننا سنراهم يفتشون عن حكم بديل لها من خلال هذه العقلية نفسها. فالحذرَ كلَّ الحذر من مثل هذه العقلية التي لا يقرها الشرع، فهي الأرض التي تنبت مثل هذه الأفكار الضالة.
والآن ماذا تعني ( المشاركة في الحكم) ، وما هي مبررات القائلين بها؟.
المشاركة تعني اشتراك المسلمين في حكم قائم على غير أساس الإسلام، ويحكم بغير أحكام الإسلام. وذلك يتم بممارسة لعبة الديمقراطية ، ودخول البرلمان بغية إيصال الرأي وحامله إلى الحكم ، ومع الوقت الوصول إلى التفرد بالحكم. ويكون ذلك على سبيل التدرج أو المرحلية التي يقرها الإسلام بنظرهم.
أما مبررات القول بجواز المشاركة عندهم فهي عقلية وشرعية.
أما العقلية منها فتتلخص بما يلي:
lإن الصورة التاريخية لوصول الإسلام إلى الحكم تبدو الآن غير ممكنة التحقيق. لأن أقطار العالم الإسلامي جميعاً تخضع لسلطات مركزية قوية، تساندها قوى دولية متعددة، تملك قوى مادية ومعنوية رهيبة، وهي ترصد تحركات العاملين للإسلام، وتحاول محاصرتهم والحيلولة دون نجاحهم. لذلك فإن القياس على السابق غير موجود.
l إن الدعوة الإسلامية كانت تنظيماً يضم كل المسلمين، فقد كانت جماعةَ المسلمين . بينما الجماعة المعاصرة تضم جماعة من المسلمين. وهذا ما يجعل الجماعة المعاصرة في موقف حرج، لأنه يوجد قاعدة عريضة من المسلمين لا تخضع لقيادتها. ومثل هذا تستفيد منه الأنظمة الجاهلية فوائد كثيرة ومتعددة، وبذلك تكون الحركة الإسلامية المعاصرة قد وضعت نفسها في الطريق الحزبي الذي تسلكه الأحزاب المعاصرة، إذا ما أرادت الوصول إلى الحكم.
ومنهج الأحزاب السياسية المعاصرة يقوم على أساليب تصل من خلالها إلى الحكم. وهذه الأساليب إما أن تكون عن طريق اللعبة الديمقراطية، وإما أن تكون عن طريق الانقلاب العسكري أو عن طريق الثورة الشعبية المسلحة.
وإن الأبواب قد سدت بوجه الحركة الإسلامية المعاصرة بحيث لا تتمكن من الحصول على قوة عسكرية داخل جيوش دولهم تمكنها من القيام بانقلاب عسكري. وسد باب الثورة الشعبية في ظل الأنظمة الاستبداية القائمة ... فلم يبق أمام الحركة الإسلام المعاصرة إلاّ الطريق الثالث ، وهو طريق العمل السياسي الحزبي، والذي يؤدي إلى المشاركة في الحكم غير الإسلامي.
ويضيفون: وأمام هذا الهدف الكبير الذي قامت الحركة الإسلامية لتحقيقه لا يمكن الاحتجاج عليه بأمور جزئية تتعارض معه. لأنه في حالة تعارض الجزئي مع الكلّي يكون الترجيح لجانب الكلي. وإن مرونة الشريعة الإسلامية وواقعيتها لا يمكن أن تحول دون تحقيق الأهداف الكبيرة بسبب معارضات جزئية ... كما لا يمكن أن توقع المسلمين في الحرج وتقصرهم على صورة واحدة من صور الوصول إلى الحكم رغم استحالتها في بعض الظروف والأوضاع ... وإذا تعذر تطبيق الصورة الأولى يمكن الانتقال إلى الثانية والثالثة أو الرابعة ... بل قد يكون من المصلحة في بعض الأحيان السير في هذه الطرق الأربعة بخطوط متوازية في مرحلة من المراحل، حتى تترجح واحدة منها في النهاية.
مناقشة التبريرات العقلية التي أوردوها وردها:
إنه يظهر من خلال عرضهم للتبريرات العقلية التي تجيز العدول عن أحكام الشرع في التغيير أن ثقافة القائلين بهذا هي ثقافة غير إسلامية ، وإن استعملوا بعض الألفاظ الأصولية والشرعية. ولا يملكون طريقة الإسلام المنضبطة في التفكير من حيث كيفية النظر إلى الواقع في استنباط الحكم الشرعي، ولا كيفية النظر إلى الحكم الشرعي نفسه. ولم يفرقوا بين الطريقة والأسلوب في العمل، ولعل طغيان فكرة مرونة الشريعة هي التي أوجدت عندهم التساهل بالأحكام الشرعية، والاستعاضة عنها بأحكام غير شرعية بحجة موافقة العصر.
إن القول بجواز أن لا نأخذ بطريقة الرسول r وبأحكام الشرع، طالما أن كثيراً من الأمور قد تغيّر، هو قول غير صحيح ولا يدل على دراسة عميقة للواقع الذي يراد تغييره. ذلك أن العبرة في الواقع هي بمواصفاته الأساسية وليست في أشكاله المتغيرة. والمجتمع بمكوناته الأساسية من ناس وأفكار ومشاعر وأنظمة، هو هو لا يتغيّر. وإن أخذ أشكالاً مختلفة كشكل القبيلة أو الدولة البسيطة أو الدولة المركبة. وسواء أكان ديمقراطياً أم ديكتاتورياً. فالعبرة بالمواصفات الأساسية. بينما الأشكال المتغيرة لا تؤثر في طريقة التغيير. فمثلاً: إن التعرض للأفكار الخاطئة والمفاهيم المغلوطة والعادات والتقاليد السقيمة في المجتمع الذي يراد تغييره هو حكم شرعي قام به الرسول r فهو عمل ثابت. ولكن المتغير في ذلك هو أن فكر المجتمع قد يكون وطنياً منحطاً، أو قومياً ضيّقاً، أو شيوعياً أو رأسمالياً مبدئياً. ومعلوم أن الفكر المبدئي هو أقوى من غيره، وإسقاطُهُ يحتاج إلى جهد أكبر. فاختلاف الأفكار قد يصعب العمل أو يسهله ولكنه لا يغير الطريق. وشكل النظام إن كان قبلياً كما كان زمن الرسول r، أم كان بسيطاً أم مركباً كما في أيامنا، لا يغير أحكام الطريقة، ولكنه من شأنه أن يعوق أو يسهل العمل. وسوءا كان النظامُ الذي يراد تغييره يعتمد في حماية نفسه وتمكينه على جيوش أم على قبائل مسلحة، فإن هناك قوة يعتمد عليها. وعمل الرسول r انصبّ على طلب النصرة من هذه القوة لإقامة الدولة الإسلامية. والرسول r عندما عمل على إيجاد المجتمع انصب عمله على المكونات الأساسية للمجتمع. فأوجد الأفراد الأقوياء بإيمانهم، المعدين إعداداً يمكنهم من حمل أعباء الدعوة وإقامة الدولة (وقد كانوا المهاجرين). وأوجد القاعدة الشعبية التي تحتضن الدعوة وحَمَلَتَها، وتقبل أن تقوم الدولة فيهم (وقد كانوا الأنصار). ومن ثم كان طلب النصرة هو طريقة استلامه للحكم. فقد أصرَّ عليها الرسول rرغم كثرة موانعها وشدة ما لاقاه أثناء طلبها، والناظر في عمل الرسول r في مكة يجد أن طريقة التغيير تتناول الركائز الأساسية، ويجد أن طريقته لا تتغير بتغير الزمان والمكان، ولا تختلف من قطر إلى قطر. لأن اختلاف ما عليه الأقطار والمجتمعات من مواصفات إنما يتعلق بالشكل لا بالجوهر. وطبيعتها أنها قد تصعب العمل أو قد تسهله.
وكذلك فإن القول بمرونة الشريعة لا يجوز أن يكون مدعاة لتمتد إليها عقول المسلمين وأهواؤهم بالتغيير ، تحت حجة المرونة هذه. فالشريعة جعلها الله كاملة بحيث أنها تتسع لمعالجة جميع مشاكل الحياة. قديمها وحديثها. ولكن ضمن الأصول المنضبطة التي تنطلق من منطلق أن الحكم هو لله وحده.
ولا يجوز أن يكون القول بسعة الشريعة مدعاة لإسقاط النصوص. أو لجعلها تتسع لما ليس منها. ولقد اسقط بعض علماء المسلمين العقوبات الشرعية تحت هذه الحجة، وذلك عندما قالوا: طالما أن مقصود الشريعة من العقوبات هو الزجر، وكل ما يزجر يمكن اعتباره موافقاً للشرع. ولمّا لم تعد العقوبات الشرعية متوافقة مع روح العصر، وصارت تمجها نفوس الناس، وتأباها عقولهم أمكن الانتقال إلى غيرها طالما أنه يحقق المقصود. ولولا أن الشريعة مرنة متطورة لما أمكننا ذلك.