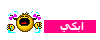جواز تعدد الحركات الإسلامية:
والآن وبعدما أوضحنا بأن ما نصب من أدلة على وجوب وحدة العمل الإسلامي لا يرقى لاعتباره دليلاً، فإن هذا لا يعني أن الرأي الآخر وهو جواز تعدد جماعات العمل صار هو المشروع على اعتبار أن نفي الشيء هو إثبات لضده، فهذا خطأ. فلا بد من أدلة منضبطة تبرز فيها صحة الاستدلال ودقة الاستنباط. فما هي هذه الأدلة؟.
إن أدلة جواز الاختلاف في الفروع دون الأصول، أي في الأحكام دون العقائد، أكثر من أن تحصى. وقد دلت السنة على جواز الاختلاف في الفروع، واختلف الصحابة فيما بينهم على ذلك، وكذلك تابعوهم، وكذلك علماء السلف. أما النهي عن الاختلاف فهو النهي عن الاختلاف الذي اختلفه الكفار فيما بينهم، وكان اختلافاً في أصول الدين لا في فروعه، كاختلافهم على أنبيائهم، واختلافهم في البعث والنشور، واختلافهم في الحياة والموت، واختلافهم في كتبهم، حتى أصبحوا شيعاً وأحزاباً ومِللاً ونِحَلاً ضاعت عن الحق الذي أنزله الله إلى أنبيائهم وأضاعوا أتباعهم عنه: ]فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ[ فحذرَنا اللهُ من مثل هذا الاختلاف الذي اختلفوا.
والرسول r أقر يوم الخندق فهْمَ الصحابة المختلف لكلامه لهم: «من كان سامعاً مطيعاً فلا يصليَنَّ العصر إلا ببني قريظة» [سيرة ابن هشام] وقول الرسول r: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» [رواه البخاري].
ويستدل من هذا الحديث:
1 - ان المجتهد يخطئ ويصيب وليس كونه مجتهداً أنه لا يخطئ.
2 - ان الحكم الذي استنبطه المجتهد يعتبر حكماً شرعياً ولو كان خاطئاً.
3 – ان المجتهد الذي أخطأ لا يعلم أنه أخطأ، وإلاّ لما جاز له البقاء على خطئه بل يرجح عنده فهمه على غيره.
4 – ان المجتهد مأجور عند الله سواء أخطأ أم أصاب. ولكن يختلف الأجر بينهما.
فهناك اتفاق بين الأئمة على أن الإثم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعية في المسائل الظنية من الفقهيات.
يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره: (ما زالت الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث وهم مع ذلك متآلفون) وقد نقل البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قوله: (ما سرني لو أن أصحاب محمد لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم يكن رخصة).
وقد أُلفتْ الكثير من المؤلفات لعلماء المسلمين الكبار تبين أسباب هذا الاختلاف:
منها أن الإنسان بطبيعته كإنسان يتفاوت الفهم عنده من إنسان لآخر، فالقدرات تختلف، والأفهام تختلف. من هنا كانت الاجتهادات والاستنباطات المختلفة منذ عصر الصحابة إلى عصرنا اليوم ، وستبقى إلى قيام الساعة، ومنها أن طبيعة الشرع تحمل المسلمين على الاختلاف وفي هذا رحمة.
- فاختلاف القراءات يؤدي إلى اختلاف الأفهام. كل مجتهد يفهم بحسب قراءته. وذلك مثل الاختلاف في آية الوضوء: أهو الغسل أم المسح بالنسبة للقدمين.
- اختلاف العلماء والفقهاء على بعض الأحاديث. فقد يكون الحديث صحيحاً عند فلان من العلماء أو الفقهاء ويكون عند غيره ضعيفاً، بحسب طريقة العالم في قبوله الحديث أو ردّه. ولنأخذ على سبيل المثال الحديث المرسل: فقد اختلف المحدثون والأصوليون والفقهاء من أئمة هذه الأمة في الاحتجاج بالمرسل. فمنهم من يحتج به، ويعتبره حجة، ومنهم من لا يحتج به، ويعتبره كالحديث المنقطع.
- تعارض الأدلة وذلك أن يأتي نص بالنهي عن التداوي بالنجس وبما هو حرام كما في الحديث: «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووْا، ولا تتداووْا بحرام» [رواه أبو داود] ثم يأتي نص آخر أو فعل آخر يبيح التداوي بالنجس أو بما هو حرام ، مثل حديث «أن النبي r رخّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحِكَّة كانت بهما» [رواه الجماعة] ومثل حديث «كان المسلمون يتداوون بأبوال الإبل لا يرون بها بأساً» [رواه البخاري].
- عدم وجود نص صريح في المسألة، فيكون سبيل معرفة حكم الله في المسألة هو الاجتهاد، والاجتهاد حكم ظني فيه قابلية الاختلاف.
- ومنها اتساع اللغة العربية في مدلولاتها كوجود الاشتراك أو الحقيقة والمجاز، والمطلق والمقيد، والعام والخاص، فطبيعة اللغة العربية التي نزل الوحي بها تحتمل ألفاظها وتراكيبها المعاني المختلفة والمدلولات المتعددة.
فقوله تعالى عن المطلقات: ]يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ[. فكلمة (قُرْء) قد تعني لغة: الطهر وقد تعني: الحيضة. فأي المعنيين هو المقصود؟ وقد كان هذا سبباً في اختلاف الفقهاء حول هذا الموضوع.
هذا بالنسبة للشريعة بشكل عام. فهل ينسحب ما ذكرناه على موضوعنا الذي نحن بصدده أم لا؟ أي هل جواز الاختلاف في الأحكام الشرعية والذي أقره الشرع يجيز تعدد الحركات أو الجماعات أو الأحزاب العاملة في التغيير، أم أن هذا الموضوع له أدلته الخاصة به والتي تخرجه عن الحكم السابق؟.
الجماعة أو الحزب يقوم على فهم شرعي قد يتعدد، مثله مثل أي فهم شرعي آخر، إلاّ إذا كانت أحكاماً قطعية. والأحكام الشرعية التي تتبناها الجماعة هي أحكام شرعية اجتهادية وفيها قابلية الصواب والخطأ. ولا يجوز لمسلم يرى الخطأ الكثير في جماعة أن يعمل معها. بل ينصحها، ويفتش عن الجماعة التي تبرأ ذمته أمام الله بالعمل معها. وكما قلت فإن طبيعة الناس وعلمائهم وطبيعة الشرع وطبيعة اللغة كلها تدل على جواز تعدد الأفهام، وهذا ما يبرر وجود أكثر من جماعة. وهذا لا ضير فيه، طالما أنه لا يعدو أن يكون خلافاً في الفهم. ويصبح العمل مع الجماعة أو الحزب الأقرب إلى الصواب هو الواجب.
وكذلك فإن قوله تعالى: ]وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ[.
فالأمر في هذه الآية منصب على وجوب إقامة جماعة منهم على الأقل، يكون عملها: الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليس المقصود من الآية وجود جماعة واحدة. وإلاّ لقال: (أمّة واحدة)، بل المطلوب هو جنس الجماعة التي يكون عملها الدعوة والأمر والنهي. وهذا الفرض هو فرض على الكفاية، ويتحقق وجوده بوجود جماعة واحدة. أما إذا وجدت أكثر من جماعة لتعدد أفهام العمل فلا شيء عليه. وهذا النوع من التعبير يتكرر في مئات الآيات والأحاديث. نحو:
حديث: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ... » فليس المقصود منكراً واحداً بل جنس المنكر.
وقد ذكر أبو الأعلى المودودي رحمة الله في كتاب (مفاهيم إسلامية حول الدين والدولة) وتحت باب: فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: "فالظاهر من كل هذا التبعيض في آية: ]وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ...[ ليس بمعنى أن المسلمين مطالبون بأن تكون فيهم جماعة تقوم بواجب الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أما بقية عامة المسلمين فليس بواجب عليهم القيام بهذه المهمة أصلاً، وإنما معناه أن من الواجب أن لا تخلو الأمة بأي حال من الأحوال من جماعة – على الأقل – تسهر على إنارة سراج الحق والخير ومكافحة ظلمات الشر وغوائل الباطل. فإنه إذا لم تكن فيها ولا جماعة كهذه فمن المحال لها البتة أن تسلم من لعنه الله وعذابه الشديد فضلاً عن أن تكون خير أمة أخرجت للناس". انتهى قول المودودي.
وبناء على ما تقدم:
- إننا يجب أن نعلم جيداً أن الذي يقره الشرع هو الرحمة. وإذا تحول إلى نقمة فإن ذلك يكون بسبب سوء فهم المسلمين ليس إلاّ. أنظروا إلى هذا الفقه الجليل من إمامين عظيمين من أئمة هذه الأمة: جاء في كتاب (شذور الذهب) أن تلاميذ الشافعي جاؤوا إليه يوماً وشكوا إليه كيف يزور الإمام أحمد بن حنبل بينما هم يتخاصمون مع تلاميذه بسبب اختلاف آرائهم، فقال لهم الشافعي رضي الله عنه:
قالـوا يزورك أحمـدُ وتـــزوره
إنْ زارنـي فبفضــلِـهِ أو زرتـه
قـلتُ : الفضـائل لا تُفارِقُ مَنْزلـِهْ
فلفضلِـهِ، والفضلُ في الحالين لَـهْ
وحدث مثل ذلك بين تلاميذ الإمام أحمد وبينه فقال لهم:
إن نختلف نسباً يؤلِّفْ بيننا
أو يخـتـلـفْ مـاءُ البحار فكلـُّنا
عِلْمٌ أقمناهُ مَقامَ الوالدِ
عَــذْبٌ تَـحَــدَّرَ مِنْ إناءٍ واحدِ
- ولمن أراد أن يجمع المسلمين كلهم في عمل واحد فهذا، فضلاً عن غفلته عن واقع الشرع، وغفلته عن واقع الناس، فإننا نقول له كما قال الإمام مالك لهارون الرشيد حينما أراد أن يتبنى فهمه ومذهبه ويلزم به الناس أو يمنع فهم الآخرين: "لا تضيق على المسلمين ما وسعه الله عليهم".
- ويجب الانتباه هنا إلى أن الدول الكافرة والأنظمة التابعة لها عندما ترى على أرض الواقع جماعة أو جماعات تعمل جادة لإقامة حكم الله فإنها، إضافة إلى استعمال أسلوب الغلظة معها وترويج الإشاعات عليها، تعمد إلى إجهاض وتفشيل هذه الجماعات عن طريق إنشاء جماعات تابعة لها. ولو فرضنا أن التعدد لا يجوز فهذا معناه أن الجماعة يجب أن تتوحد مع غيرها، وستحوي بذلك الغث والسمين. والعكس في هذه الحال هو المطلوب. فإنه يجب اطراح الغث والإبقاء على ما ينفع الناس.
- لما كان هذا الطرح، أي وجوب وحدة العمل الإسلامي وعدم جواز تعدديته، يخالف واقع الشرع وواقع الإنسان وواقع اللغة التي نزل بها الوحي، فإن هذا يجعله طرحاً لا يمكن تحقيقه. ويبقى الكلام فيه ألْهية عن العمل الأهم، وهو العمل لإقامة الخلافة. والقول بأن الله لا ينصر المسلمين إلاّ إذا توحدوا هو تحكم غير مقبول. بل إن الله لا ينصر المسلمين إلاّ إذا تقيدوا بالشرع، واعتصموا بحبل الله وقاموا بأمره. فإن الله ينصرهم وإن كانوا قلة. فالواحد على الحق كثير ، والكثير على الباطل غثاء.
- وبقي أن نقول كلمة في هذا الموضع، وهي أن وجود الخليفة، ووجود الدولة الإسلامية هو أهم مظهر من مظاهر توحد المسلمين، ولا يوجد توحد خارجه. تبقى الأفهام مختلفة ولكننا مأمورون بطاعته. فالإمام يتبنى، وهو بتبنيه يرفع الخلاف ولا يمنعه أو يزيله. وأمره نافذ ظاهراً وباطناً على المسلمين. أما أمير الحزب فإن أمره نافذ ضمن حزبه ويرفع الخلاف بين أعضاء حزبه وليس بين عامة المسلمين.