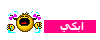والآن، وبعد استعراض: ماذا يعني التدرج، وماذا يشمل، وما هي مسوّغاته عند القائلين به، ننتقل إلى بيان الرأي الشرعي الصائب، وبالطريقة الشرعية في التفكير.
أقول الرأي الصائب ولم أقل الرأي الأقرب إلى الصواب؛ لأن فكرة التدرج هذه ليست من الشرع ولا يجوز نسبتها إلى الشرع. والمسألة لا تتعلق بالتدرج: هل هو حكم شرعي أو لا، بقدر ما يتعلق بطريقة تفكير لا يقرها الشرع بحال من الأحوال.
ذلك أن للإسلام طبيعة تختلف جذرياً عن غيره. فطبيعة النظام الإسلامي أنه قائم على اتباع الوحي حصراً. بينما تقوم طبيعة النظام الوضعي على الابتداع الإنساني والخبرات البشرية والتي تبقى مهما قويت قاصرة على تحديد المعالجات الصحيحة لمشاكل الإنسان.
والمسلم عندما يتقيد بالشرع عليه أن يجعل أساس تقيده الإيمان بالله تعالى. وإلا فلن يقبل منه التزامه وعندما يدعو غيره إلى الإسلام عليه أن يجعل أساس دعوته الإيمان بالله، وإلا فلن تقبل منه دعوته. فالمسألة تتعلق بالإيمان أولاً، والالتزام الصحيح ثانياً.
وحتى يتغير المسلم ويغير الأنظمة تغييراً صحيحاً وسليماً يجب أن يهتم بالأساس الروحي: بإيجاده أولاً ومن ثم تغذيته. فيسهل بعدها الالتزام، بغض النظر عن مطابقته لواقع الناس أو طباعهم أو أهوائهم أو عدم مطابقته. وعدم اعتماد المسلم على الأساس الروحي في الالتزام يوقعه في الإثم إن لم يؤدِ به إلى الكفر. وقيام الإسلام على الأساس الروحي أي الإيمان بالله لا يجعل هذا الحكم قريباً أو بعيداً إلا بقدر قربه أو بعده عن هذا الأساس.
والآن نأتي لنسأل من يقول بالتدرج: أين هو الأساس الروحي في هذه الدعوة . بل أين أمر الله به. وأين لجأ الرسول r، مع مسيس الحاجة إليه، سواء في مكة أم في المدينة؟.
ألم يقل الرسول rلبني عامر بن صعصعة حين كان يطلب منهم النصرة «الأمر لله يضعه حيث يشاء» [سيرة ابن هشام]. وذلك عندما طلبوا أن يكون الأمر فيهم من بعده مع شدة الحاجة عنده لوجود من ينصر الدعوة. ألم يكن في الإمكان إجابتهم إلى طلبهم، ثم بعد أن يؤمنوا تتغير مطالبتهم؟ أم هي الدعوة الصادقة والأمر الرباني الذي جعله صادقاً فيما يقول من غير مداهنة ولا مساومة ، ليحيا من حيَّ عن بينة ويهلك من هلك عن بينة.
ألم يقل الرسول rلعمه أبي طالب عندما جاءه يطلب منه أن يخفف عنه وأن لا يحمّله من الأمر ما لا يطيق، ألم يقل له: «والله يا عماه لو ضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه». [سيرة ابن هشام] وهذا النص من الرسول r يفيد عدم قبوله بأدنى مساومة، وأعطى على ذلك أصدق مثل في دعوته. فلم يداهن ولم يهادن، ولم يساير ، ولم يحابِ، ولم يداجِ من بيدهم الأمور بل كانت دعوته صريحة جريئة، تبعث الفكر الصادق الذي يُدحض به الباطل ويجعله زهوقاً.
ألم يأمر الله سبحانه المسلمين أن يهاجروا من المكان الذي لا يستطيعون أن يقوموا فيه بما أوجبه عليهم إلى المكان الذي يستطيعون ، وجعل المكوث فيه محرماً عليهم لقوله تعالى: ]إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا[ وقد نقل ابن كثير الإجماع على تحريم الإقامة حيث لا يتمكن المسلم من إقامة الدين.
ألم يبدأ الرسول r دعوته بـ (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وبادأ بها قومه. وكانت كذلك هي آخر كلامه من غير أي تغيير. فهل دعا إلى أقلّ منها في بادئ الأمر ثم تدرج بها؟ أم أنها كانت أول دعوته وآخرها.
ألم يقاتل أبو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة، ولم يأخذهم بالتمهل وتطييب الخاطر، قائلاً قولته المشهورة: "والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه". مع أن وضع المسلمين كان يومها يشهد حركة ارتداد وتمرد واسعين.
هل عهد عن المسلمين الأوائل الذين حملوا الدعوة إلى الإسلام مثل هذا الفهم. وهل ساروا على منواله حين طبقوا الإسلام على البلدان المفتوحة التي تحولت دارها من دار كفر إلى دار إسلام؟ لم يراعِ المسلمون الأوائل أوضاع أهل هاتيك البلاد الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام. فلم يتركوهم يشربون الخمرة ريثما تألف نفوسهم عدم شربها أو عدم التعامل بالربا أو عدم معاقرة النساء ... بل كانوا يدخلون في الإسلام كاملاً فيمتنعون عن الربا وعن الزنا وعن الخمر وعن كل ما حرمه الله عليهم . وكانوا ينفذون الأحكام الشرعية المتعلقة بذمتهم سواء منها الفردية أم الجماعية، العينية أم الكفائية.
هل تناولت أمهات كتب الفقه الإسلامي هذا الموضوع، وهل ذكر فقهاؤنا المجتهدون الأوائل الموثوقون أدنى إشارة عن التدرج، ومعلوم أن فقهاءنا تناولوا بالتفصيل كليات الشريعة وجزئياتها؟.
إن الشرع بكليته يدل على وجوب تحلي الدعوة بالصدق واستقامة الطريق: ]الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا @ قَيِّماً... [والله أخبرنا أن الكفار يودون أن نداهنهم ونسايرهم ونتنازل عن الحق، ونقبل بأرباع الحلول وأنصافها بدءاً بالكفر لقوله تعالى: ]وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم... [ وانتهاء بالأحكام لقوله تعالى: ]وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ[، ]فلا تطع المكذبين[ وقد حذرَنا ربُنا من الركون إلى الظالمين بقوله: ]وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ[.
إن الدعوة الصادقة إلى الإيمان الصادق تجعل التزام المسلم كاملاً، ولو كان حديث عهد بالإسلام أو بالالتزام. وما علينا كحملة دعوة إلا أن نغرس الإيمان في النفوس، وأن نعتني به حتى يؤتي أكله على أطيب ما يكون التزاما وتقوى. والدولة الإسلامية حين تقوم لن تقوم على أناس فارغين أو مثقلين بالأفكار الغربية. ولن تقوم على أناس لم تعمل الدعوة فيهم ولم تؤثر عليهم وتجعلهم يقبلونها. بل هي كما قلنا سابقاً ، يجب أن تقوم على رأي عام منبثق عن وعي عام يتقبل فكرة الإسلام وفكرة الحكم به. ولا حاجة للجوء إلى فكرة التدرج بحجة تقريب النفوس من الإسلام. ولا حاجة للرضوخ لضعف الإنسان أو مسايرة الواقع، لأن الله أمرنا أن نغير النفوس والواقع بالإسلام.
ولو عدنا إلى القرآن نستقرئ آياته لأدركنا أن الأمر فيه قطع، وأن التدرج هو من الأفكار الدخيلة الغريبة التي أدخلها من تَسَمّى بالعلم زوراً وبهتاناً.
لقد كان الرسول r والمسلمون معه كلما نزلت آية بادروا بتنفيذها دون أدنى مهلة أو تأخير. وكان الحكم الذي ينزل يصبح واجب التطبيق بمجرد نزوله. وصار المسلمون بعد نزول قوله تعالى: ]الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً[ مطالبين بتطبيق الإسلام كله مطالبة كلية. سواء منها ما يتعلق بالعقائد أو العبادات أو الأخلاق، أو المعاملات، وسواء أكانت هذه الأحكام تتعلق بناحية الحكم والاقتصاد أم الاجتماع أم السياسة الخارجية، في حالة السلم أو في حالة الحرب.
- وقوله تعالى: ]وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[ أي خذوا واعملوا بجميع ما آتاكم الرسول وانتهوا وابتعدوا عن كل ما نهاكم عنه. لأن (ما) في الآية من صيغ العموم فتشمل وجوب العمل بجميع الواجبات ووجوب الانتهاء والابتعاد عن جميع المنهيات. والطلب بالأخذ والانتهاء الوارد في الآية يفيد الوجوب بقرينة ما ورد في نهاية الآية من الأمر بالتقوى والوعيد بالعذاب الشديد لمن لم يعمل بهذه الآية.
- وقوله تعالى: ]وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ[ كذلك فإنها آية تأمر أمراً جازماً الرسول r والمسلمين من بعده بوجوب الحكم بجميع ما أنزل الله من الأحكام أمراً كانت أم نهياً. وكذلك فيها نهي للرسول r وللمسلمين من بعده عن اتباع أهواء الناس والانصياع لرغباتهم ، وكذلك فيها تحذير للرسول rوللمسلمين من بعده أن يفتنه الناس وأن يصرفوه عن تطبيق بعض ما أنزل الله إليه.
- وقوله تعالى: ]وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[.
وقوله تعالى: ]وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ[.
وقوله تعالى: ]وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[.
في هذه الآيات جعل الله من لم يحكم بما أنزل الله كافراً أو ظالماً أو فاسقاً. ولأن (ما) الواردة هنا من صيغ العموم فتشمل جميع الأحكام الشرعية التي أنزلها الله أوامرَ كانت أم نواهي.
من كل ما تقدم يتضح بشكل قطعي لا لبس فيه أنه يجب على المسلمين جميعاً أفراداً وجماعات ودولة أن يطبقوا أحكام الإسلام كاملة دون تأخير أو تسويف أو تدريج. وأنه لا عذر لفرد جماعة أو دولة في عدم التطبيق.
والتطبيق بالتدرج يتناقض مع أحكام الإسلام كل المناقضة. ويجعل المطبِّق لبعض الأحكام والتارك لبعضها آثماً عند الله فرداً كان أو جماعة أو دولة.
فالواجب يبقى واجباً يجب العمل به، والحرام يبقى حراماً يجب الابتعاد عنه. فالرسول r لم يقبل من وفد ثقيف أن يدع لهم صنمهم اللات ثلاث سنين، أو أن يعفيهم من الصلاة على أن يدخلوا في الإسلام، لم يقبل منهم ذلك، وأبى عليهم كل الإباء، وأصر على هدم الصنم دون تأخير، وعلى الالتزام بالصلاة دون تأخير.
والله قد جعل الحاكم الذي لا يطبق جميع أحكام الإسلام أو يطبق بعضها ويترك بعضها الآخر كافراً إن كان لا يعتقد بصلاحية الإسلام أو لا يعتقد بصلاحية بعض الأحكام التي ترك تطبيقها. وجعله ظالماً وفاسقاً إن كان لا يطبق جميع أحكام الإسلام، أو لا يطبق بعضها لكنه يعتقد بصلاحية الإسلام للتطبيق.
والرسول r أوجب قتال الحاكم وإشهار السيف في وجهه إذا أظهر الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. أي إذا حكم بأحكام الكفر التي لا شبهة أنها أحكام كفر، كثيرة كانت هذه الأحكام أم قليلة، لما ورد في حديث عبادة بن الصامت: «... وأن لا ننازع الأمر أهله قال: إلاّ أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان» [رواه مسلم].
وعليه فلا تساهل ولا تدرج في تطبيق أحكام الإسلام. إذ لا فرق بين واجب وواجب ولا بين حرام وحرام، ولا بين حكم وآخر. فأحكام الله جميعاً سواء. ويجب أن تطبق وأن تنفذ دون تأخير أو تسويف أو تدريج. وإلا انطبق علينا قول الله تعالى: ]أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ[.
وليس هناك من عذر لأي مسلم في عدم تطبيق أي حكم شرعي حاكماً كان أو فرداً عادياً إلا إذا كانت هناك رخصة شرعية وردت في النصوص الشرعية. وعدم القدرة يعتبر رخصة شرعية في حالة العجز الحقيقي المحسوس (أو الراجح على الظن رجحاناً قوياً)، أي حالة الاضطرار الحقيقي، مثل حالة المكره إكراهاً ملجئاً ، أو مثل حالة عرض الرسول r ثلث ثمار المدينة على قبيلة غطفان، أو مثل قبول الخليفة للتحكيم مع البغاة، أو مثل إباحة الميتة للمضطر الذي يخشى الهلاك.
ونحن، تُجاه ما نراه من هذا الطرح، نجد أن هذه الفكرة قد وجدت في رؤوس أصحابها، نتيجة لضغط الواقع، وللتلفت من هذا الضغط راحوا يتصيدون لها الأدلة تصيداً لتكون مبرراً ومسوِّغاً لهم للدعوة بحسبها. إذ أن الفكرة وجدت أولاً ومن ثَمّ أوجدوا الدليل الشرعي الذي أولُّوه بحيث يخدم هذه الفكرة. وهذه هي بداية الانحراف. وكنصيحة للخروج من هذا المنحى: يجب أن يخلع المسلمون القائمون على فكرة التدرج ثوب الضعف الذي يلبسونه، وأن يتصلوا بالشرع اتصال الواثق بربه المؤمن به إيماناً راسخاً بأنه هو الذي يدبِّرُ الأمر ويغيِّر الأوضاع، ويمنح النصر لمن يستحقه، حتى يواجه بهذا الإيمان شدة الواقع وقساوة الأوضاع. فيستعلي بإيمانه ويجعله منطلق الدعوة ومحط رحالها. وسنرى أن ذلك كله سينعكس على المدعوين تقيداً صحيحاً والتزاماً قويماً. من غير ما حاجة إلى التدرج.
إن الدعوة إلى التدرج هي دعوة لغير الإسلام ، وهذا حرام. وهذا يجعل غير المسلم، أو المسلم المقصِّر الذي يُدعى بناء على هذا الأساس متردداً في قبول ما يعرض عليه، وهذا التردد يتحمل مسؤوليته الداعي إلى التدرّج، لأنه لم يعرض عليه الإسلام، ولبعد طرحه عن الأساس الروحي القائم على الإيمان بالله الخالق المدبِّر، والذي بناءً عليه يؤخذ الحكم الشرعي أو يترك. وهذا يجعل حجة الله قائمة على هؤلاء المسلمين الداعين بدل أن تقوم حجتهم على غيرهم.
والدعوة إلى التدرج فيها تدخُّل وتحكُّم في التشريع حين تجيز للإنسان تطبيقاً مجزَّأً بحجة أنه لا يقوى على التطبيق الكامل الفوري. ونحن أُمرنا أن لا نقدم بين يدي الله ورسوله ولا نؤخر. فالذي يعالج الإنسان هو ربه العليم الخبير الذي يعلم ما خلق. فكيف يسمح المسلم لنفسه حين الدعوة للتدرج بالتدخل في عملية التشريع هذه. والصحيح هو أن تنحصر مهمة الداعي في تنفيذ وتبليغ المعالجة وليس في وضعها.
والدعوة إلى التدرج تعطي الداعي طريقة تفكير فاسدة يدعو الناس على أساسها. وهذه الطريقة التي سيحملها للآخرين إذا تأثر بها المدعو فإنها تفسد عنده طريقة التفكير التي يجب أن تتغير كما يجب أن تتغير الأفكار الخاطئة، علماً أن طريقة التفكير تأتي في المقدمة في عملية التغيير، إذ أنها تسبق في أهميتها تغيير الأفكار. ونحن لا نضمن تغير الأمة تغيراً موثوقاً حتى نغيِّر لها طريقة تفكيرها ولو بشكل عام. وستحل هذه الطريقة الفاسدة التي يفكر ويدعو بحسبها محل الطريقة الصحيحة.