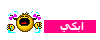مفاهيم الإسلام ضوابط لسلوك الإنسان في الحياة
أفكار الإسلام هي مفاهيم وليست معلومات لمجرد المعرفة. ومعنى كونها مفاهيم أن لها مدلولات واقعة في معترك الحياة، وليست مجرد شرح لأشياء يفرض المنطق المجرد وجودها. بل كل مدلول تدل عليه له واقع يمكن للإنسان أن يضع اصبعه عليه، سواء أكانت مفاهيم عميقة تحتاج إلى عمق واستنارة لإدراكها، أو كانت ظاهرة يمكن فهمها بسهولة. وسواء أكانت محسوسة بالحواس، لها واقع محسوس كالمعالجات والأفكار والآراء العامة، أو كانت مغيَّبة ولكن الذي أخبرنا عنها قد قطع العقل حساً بصدقه، كالملائكة والجنة والنار. فكلها وقائع موجودة لها مدلولات واقعة حساً وذهناً، أو مدلولات واقعة ذهناً على شكل قطعي جازم.
إلاّ أن هذه المدلولات الواقعة ليست أبحاثاً في الفَلَك، ولا معلومات في الطب، ولا أفكاراً في الكيمياء قد جاءتنا للانتفاع بما في الكون، وإنّما هي ضوابط لسلوك الإنسان في هذه الحياة الدنيا ونحو الحياة الأخرى، ولا علاقة لها بغير ذلك مطلقاً. فهي قد جاءت هدى ورحمة وموعظة، وجاءت معالجات لأعمال الإنسان وتعييناً لكيفية سلوكه. وإذا تتبعنا هذه المفاهيم في النصوص التي صدرت عنها هذه المفاهيم، وبعبارة أخرى التي تضمنت الأفكار الدالة على هذه المفاهيم، نجد أنها جميعها من غير استثناء جاءت على هذا الوجه دون سواه، وحُصرت في هذه الناحية وحدها. فنصوص القرآن والسنّة في منطوقها –وهو ما دل عليه لفظ الجملة- ومفهومها –وهو ما دل عليه معنى الجملة- أو دلالتها –وهو ما يقتضيه معنى الجملة- فإنها كلها محصورة في إطار واحد هو العقيدة وما ينبثق عنها من أحكام ويُبنى عليها من أفكار، ولا يوجد شيء غير هذا.
وعلى هذا كان لزاماً على المسلم أن يدرك في نصوص الشريعة وهي الكتاب والسنّة، أنها جاءت للعمل بها، وجاءت خاصة بسلوكه في الحياة. أي يجب على المسلم أن يدرك في الإسلام أمرين اثنين:
أحدهما أنه جاء بمفاهيم لضبط سلوكه في الحياة الدنيا ونحو الحياة الأخرى، فيأخذ كل فكر قانوناً لضبط سلوكه ضمن هذا القانون. فتظهر فيه الناحية العملية لا الناحية التعليمية. ويجب أن يكون واضحاً أنه إذا أُخذت فيه الناحية التعليمية وحدها فَقَد صبغته الأصلية وهي كونه قانوناً لضبط السلوك، وصار معرفة كمعارف الجغرافيا والتاريخ. فيَفقد بذلك حرارة الحياة الموجودة فيه، ويصبح ليس إسلاماً بحتاً، وإنّما معارف إسلامية، يستوي في الإحاطة بها المستشرق الكافر الذي لا يؤمن بها، والذي يتعلمها ليحاربها ويحارب أهلها، مع العالِم المسلم الذي يؤمن بها ولكنه ينقّب عنها كمعلومات، وكلذّة علمية، دون أن يخطر بباله أن يتخذها ضوابط لسلوكه في الحياة.
ومن هنا كانت معرفة الأفكار الإسلامية، والأحكام الشرعية، دون تحقيق اعتبارها ضوابط للسلوك الإنساني في الحياة، هي الآفة التي لم تجعل للإسلام أثراً في سلوك حياة المسلمين اليوم.
أمّا الأمر الثاني الذي يجب على المسلم أن يدركه في الإسلام هو أن القرآن والحديث إنّما جاءا ديناً وشريعة لا معارف وعلوماً، وأنه لا دخل لهما بأي علم من العلوم، لا بالتاريخ ولا بالجغرافيا، ولا بالطبيعيات أو الكيمياء، ولا بالاختراعات أو بالاكتشافات.
أمّا ما ورد في القرآن من آيات عن القمر والنجوم والكواكب وعن البحار والجبال والأنهار والحيوان والطير والنبات كقوله تعالى: (والشمس تجري لمستقر لها) (التي تطّلع على الأفئدة) إلى غير ذلك من الآيات، فليس لها أية دلالة على أي علم من العلوم وإنّما هي لفت نظر إلى قدرة الله، وأدلة على عظمة الله وآيات تدل الإنسان على ما يُقنع عقله بضرورة الإيمان بالله سبحانه وتعالى.
فهي أدلة قدرته وعظمته، ولفت نظر للعقول لتدرِك وتتعظ، وليس لأي بحث في المعرفة أو العلم.
وعلى ذلك فإن أفكار الإسلام التي جاء بها القرآن والحديث لم تأت لمجرد المعرفة ولا للبحث التعليمي، وإنّما جاءت لمعالجة مشاكل الإنسان، فهي ضوابط لسلوكه في الحياة الدنيا ونحو الحياة الأخرى.
العقوبات في الإسلام
شرع الله العقوبات في الإسلام زواجر وجوابر. زواجر لزجر الناس عن ارتكاب الجرائم، وجوابر تجبر عن المسلم عذاب الله تعالى يوم القيامة.
أمّا كون العقوبات في الإسلام زواجر، فهذا ثابت بنص القرآن. قال تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب). فكون الله تعالى جعل في القصاص الحياة معناه أن إيقاع القصاص هو الذي أبقى الحياة، ولا يكون ذلك في إبقاء حياة من وقع عليه القصاص، ففي القصاص يكون موته لا حياته، بل حياة من شاهد وقوع القصاص. على أن الغالب من حال العاقل أنه إذا علم أنه إذا قتل غيره قُتل هو، فإنه لا يُقدم على القتل. وهكذا جميع الزواجر.
أمّا هذه العقوبات فلا يجوز أن توقَع إلاّ بالمجرم، لأن معنى كونها زواجر أن ينزجر الناس عن الجريمة، أي يمتنعوا عن ارتكابها.
والجريمة هي الفعل القبيح، والقبيح ما قبحه الشرع. ولذلك لا يعتبر الفعل جريمة إلاّ إذا نص الشرع على أنه فعل قبيح فيُعتبر حينئذ جريمة.
وليست الجريمة موجودة في فطرة الإنسان، ولا هي مكتسَبة يكتسبها الإنسان، كما أنها ليست مرضاً يصاب الإنسان به، وإنّما هي مخالفة النظام الذي ينظم أفعال الإنسان.
وذلك أن الإنسان قد خلقه الله تعالى وخلق فيه غرائز وحاجات عضوية، وهذه الغرائز والحاجات العضوية طاقات حيوية في الإنسان تدفعه لأن يسعى لإشباعها، فهو يقوم بالأعمال التي تصدر عنه من أجل هذا الإشباع.
وترْك هذا الإشباع دون نظام يؤدي إلى الفوضى والاضطراب، ويؤدي إلى الإشباع الخاطئ أو الإشباع الشاذ.
وقد نظم الله تعالى إشباع هذه الغرائز والحاجات العضوية حين نظم أعمال الإنسان بالأحكام الشرعية. فبيّن الشرع الإسلامي علاج أعمال الإنسان في الخطوط العريضة التي هي الكتاب والسنّة، وجعل في هذه الخطوط العريضة محل الحكم في كل حادثة تحدث للإنسان. وشرع الحلال والحرام، فجاء بما يُستنبَط منه حكم كل فعل من أفعال الإنسان، وبيّن الأشياء التي حرّمها على الإنسان. ولهذا ورد الشرع بأوامر ونواه وكلف الإنسان العمل بما أمره به، واجتناب ما نهاه عنه. فإذا خالف الإنسان ذلك فقد فعل الفعل القبيح، أي فَعَل جريمة، سواء أكان ذلك عدم القيام بما أمر به أو كان فعل ما نهى عنه، ففي كلتا الحالتين يعتبر أنه فعل الجريمة. فكان لا بد من عقوبة لهذه الجرائم حتى يأتمر الناس بما أمرهم الله به، وينتهوا عما نهاهم عنه، وإلاّ فلا معنى لتلك الأوامر والنواهي إذا لم يكن عقاب على مخالفتها، إذ لا قيمة لأي أمر يُطلب القيام به إذا لم يكن مقابله ما يعاقَب به من لا يقوم بهذا الطلب، سواء أكان طلب فعل أم طلب ترك.
وقد بين الشرع الإسلامي أن على هذه الجرائم عقوبات في الآخرة وعقوبات في الدنيا. أمّا عقوبة الآخرة فالله تعالى هو الذي يعاقب بها المجرم فيعذبه يوم القيامة، قال الله تعالى: (يُعرف المجرمون يومئذ بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام)، وقال تعالى: (والذين كفروا لهم نار جهنم) (هذا وإن للطاغين لشرّ مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد) (إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراً).
وقد بين الله تعالى هذه العقوبات صريحة في القرآن، فهي واقعة حتماً لأنها جاءت في آيات قطعية الثبوت قطعية الدلالة، قال تعالى: (إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يُسحبون في الحميم ثم في النار يُسجرون) (ليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلاّ من غِسلين لا يأكله إلاّ الخاطئون) (يًصب فوق رؤوسهم الحميم) (إن المجرمين في ضلال وسُعُر يوم يُسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مَسّ سَقَر) (في سموم وحميم وظل من يحموم) (لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شُرب الهيم) (فنُزُلٌ من حميم وتصلية جحيم) (كلا إنها لظى نزاعة للشوى) (خذوه فغُلّوه ثم الجحيم صلّوه ثم في سلسلة ذَرعُها سبعون ذراعاً فاسلكوه) (كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب).
وهكذا تبين آيات كثيرة عذاب الله بياناً قطعياً بأسلوب معجز، وأن الإنسان حين يسمعها لَيَأخذه الهول، ويتولاه الفزع، ويهُون عليه كل عذاب في الدنيا، وكل مشقة مادية، إذا تصور عذاب الآخرة وهوله، فلا يُقدِم على مخالفة أوامر الله ونواهيه إلاّ إذا نسي هذا العذاب وهوله.
هذه عقوبة الآخرة، أمّا عقوبة الدنيا فقد بيّنها الله في القرآن والحديث مجمَلة ومفصَّلة. وجعل الدولة هي التي تقوم بها. فعقوبة الإسلام التي بيّن إيقاعها على المجرم في الدنيا يقوم بها الإمام أو نائبه، أي تقوم بها الدولة الإسلامية بتنفيذ حدود الله، وما دون الحدود من التعزير والكفّارات. وهذه العقوبة في الدنيا على ذنب معين من قِبل الدولة تُسقِط عن المذنب عقوبة الآخرة. فتكون بذلك العقوبات زواجر وجوابر، فتزجر الناس عن فعل الذنوب وارتكاب الجرائم والآثام، وتجبر عقوبة الآخرة فتسقط عن المسلم عقوبة الآخرة.
والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس: تبايعوني على أن لا تُشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفّارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله، فأمْرُه إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. فبايعناه على ذلك).
وهذا صريح في أن عقوبة الدنيا من الإمام أو نائبه على ذنب معين تُسقِط عقوبة الآخرة، ولذلك كان كثير من المسلمين يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرّون بالجرائم التي فعلوها ليوقع عليهم الحد في الدنيا حتى يسقط عنهم عذاب الله يوم القيامة، فيحتملون آلام الحد والقصاص في الدنيا لأنه أهون من عذاب الآخرة.